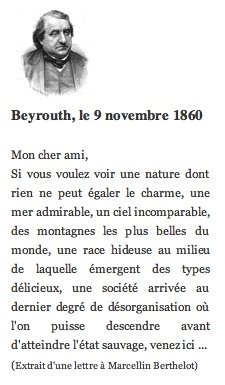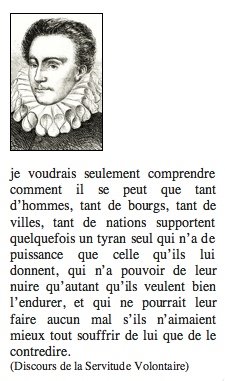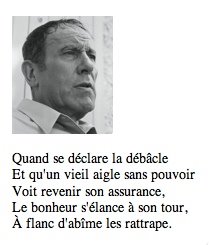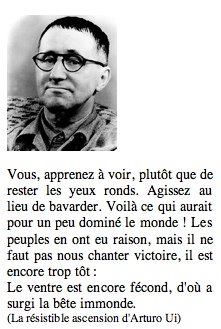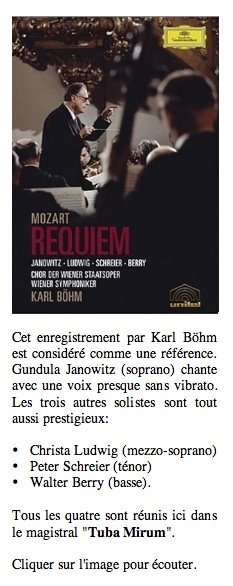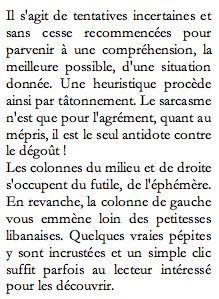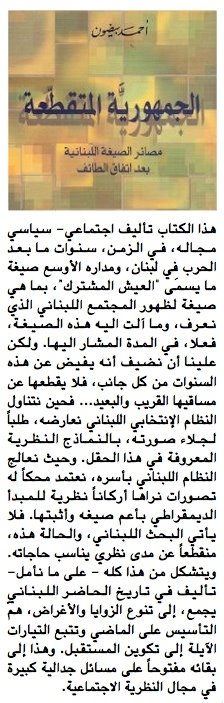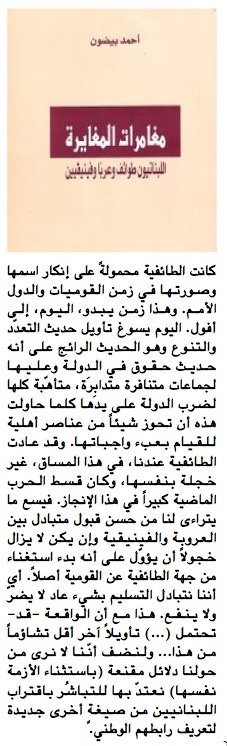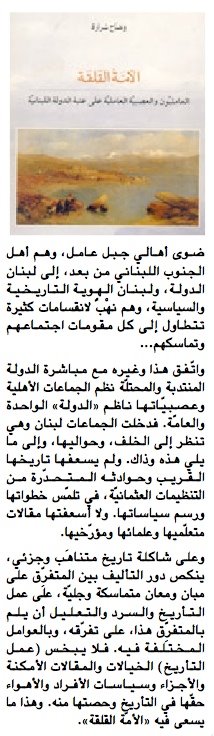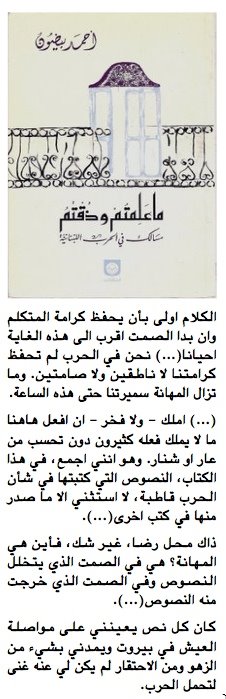Le coût politique de la corruption
الكلفة السياسية للفساد
أحمد بيضون
أحمد بيضون
الأصل وفروعه
ليس للفساد في لبنان من كلفة سياسية أولى. ولكن له، في السياسة، كلفة ثانية. وأقصد بالكلفة الأولى أن يكون الفساد أصلا لنفسه، غير متفرع من بنى النظام السياسي (وغيره) وأن يقع فعله، بهذه الصفة، على هذا الأخير. وأقصد بالكلفة الثانية أن يكون الفساد فرعا من النظام السياسي (وغيره) ثم يعود ليرزح على هذا الأخير ويزيد فيه خللا على خلل. وأقول إن افتراض الأمر الأول يزوغ عن واقع العلاقة بين هذين الطرفين وإن افتراض الأمر الثاني يصف هذه العلاقة وصفا محكما ويهدي من شاء نقضها إلى موطن الفعل الحاسم.
وذاك أن الفساد، من حيث أصله، كلفة من كلف نظام العصبيات الذي يرسم البنية العامة، الاجتماعية عموما والسياسية خصوصا، للدولة اللبنانية ويملي أهم القواعد المتحكمة في سلوكها والضابطة للتصرفات فيها. ولا يعني هذا ألا نفترض للفساد عندنا أصولا أعمّ من النظام اللبناني قد يجعلها بعضنا في الطبيعة البشرية أي في الأنانية التي تحمل البشر ، أفرادا وعصبا، على أن يسخّروا لنيل ما يجدونه صالحا لهم ما ليس من حقهم تسخيره وما تجعله القواعد المقررة في مجتمع من المجتمعات صالحا لغيرهم أو صالحا عاما غير مخصص لفرد من الأفراد أو لعصبة من العصب بالذات.
على هذا المستوى، يصبح الفساد، بما هو افتئات من الخاص على العام، وجها من وجوه الجنوح والجريمة الماثلين في كل مجتمع من مجتمعات البشر ويعود غير مستقل بصفة نوعية له تميزه عن سائر ضروب الجنوح والجريمة إلا بمقدار ما ينماز بعض هذه الضروب عن بعض، على التعميم. ويعود الفساد، حين ينظر إلى هذا النوع من العلية، غير مختص بالنطاق اللبناني، طالما أن هذه العلية ليست بلبنانية على التخصيص. ويفضي بنا الاقتصار على هذا الاعتبار إلى فصل الفساد عن أي نظام سياسي، مهما يكن، وعن النظام اللبناني، بالتالي، وإلى الانصراف عن طلب المعالجة والإصلاح في نطاق نظامنا السياسي، بل في نطاق المجتمع اللبناني كله أيضا. فإن صورة المعالجة والإصلاح تميع، في هذه الحالة، لتنتشر في الضرورة العامة للرقي بالبشر، كائنين من كانوا، أي لصوغهم صوغا جديدا عبر إعادة تربيتهم. وفي هذا – على ما نرى – ما فيه من إبعاد للمعالجة عن أي تحديد ومن قطع للسبل بينها وبين أي أفق حسي ومن تحويل لها، بالنتيجة، إلى ثرثرة جوفاء وبرق خلّب. وهذا تحويل يذكّر في لبنان – ولو بمجرّد تداعي الأفكار – بالرد الجاهز إلى أولوية النفوس على النصوص كلما فتح لبناني فاه بذكر لجرائر الطائفية على مجتمعنا هذا.
في الاتجاه المقابل، لا تعني نسبة الفساد، من حيث أصله، إلى نظام العصبيات أن نعزف عن النظر في مواطن جزئية للفساد، يقوم كل منها برأسه في مطاوي هذا النظام وتضاعيفه وتشكّل للفساد الراتع فيه حلقة خاصة لا يتعذّر كسرها في موضعها بالذات، من غير أن يقرن إمكان هذا الكسر، بالضرورة، بتغيير (قد يطول انتظاره أو قد نكون، في اللحظة السياسية الاجتماعية التي نحن فيها، بعيدين جدا عنه) لقاعدة النظام السياسي العامة، أي لتحكم العصبيات في حركة هذا النظام. هذه المواطن المحدّدة للفساد يتعين النظر في التصدي لها دائما ويجب الإقدام على إصلاح فسادها حيث يمكن ذلك من غير انتظار لأية حملة عامة أو تغيير جذري. بل إن التلكؤ في الإصلاح الجزئي لا يجاوز – على الأرجح – أن يبعدنا عن إمكان الحملة العامة وعن أفق التغيير الجذري. ولنا أن نزيد أن الحملة العامة والتغيير الجذري لا يجوز تصورّهما على أنهما هبّة رجل واحد تحصل في لحظة مفردة من الزمن. وإنما هما، بالضرورة، مسيرة طويلة متعرجة وسلاسل من الإجراءات المتنوعة صفاتها ومصادرها والمتعددة مستوياتها.
الفساد وأخواته
حتى إذا قررنا أن الفساد كلفة من كلف نظامنا السياسي الاجتماعي، توجب أن نسأل ما هي الكلف الأخرى لهذا النظام؟ نحصي من بين هذه الكلف ثلاثا رئيسة: 1- الميل شبه الدوري بما يفترض أن يكون صراعا سياسيا نحو التحول إلى تنازع أهلي له صفة العنف. 2- التعريض المتكرر والمتمادي للاستقلال الوطني وتعريض دعائمه نفسها للتقويض شبه الدوري أيضا بتوفير الركائز الداخلية العريضة لهيمنة خارجية أو لهيمنات. 3- مصادرة الأفراد- المواطنين بزجّهم طوعا أو عنوة في جماعاتهم العصبية وإلجائهم إلى طلب الدعم العصبي عند وقوفهم أمام ما يعرض للإنسان من مشكلات طوال حياته، سواء أكانت هذه المشكلات من النوع الذي يقتضي، بطبيعته، هذا الدعم أم كانت من النوع الذي يفترض أن يكفي لمعالجته تطبيق القوانين والأنظمة أو رعاية الدولة لمواطنيها.
ليس هذا موضع التبسط في شأن هذه الكلف. فنكتفي في موضوعها بإشارتين. الأولى إلى كونها – شأن الفساد – مشتقة من الأصل الذي هو النظام العصبي وليست أصلا لذاتها. ولكنها تعود لترقى – على المستوى السياسي – إلى مقام العوامل الأصلية، مرتّبة بدورها على النظام كلفا سياسية باهظة. والإشارة الثانية إلى كون أي من هذه الكلف لا يصحّ فصلها إلا نظريا عن الفساد. فهي تؤازره وتؤيده وهو يرسّخها ويمدّ في أعمارها.
العصبيات: من التداخل إلى الاستيلاء
نعود عمّا قليل إلى كيفيات ارتداد الفساد على نظام العصبيات المتحكّم بمصائرنا وعلى ما يسوّغه أو يستدعيه من مسالك وتصرفات. لكن علينا أن نغامر، قبل ذلك، بتحديد ما لما نعنيه إذ نضيف النظام إلى العصبيات وبوصف مجمل لحركة العلاقة بين المضاف والمضاف إليه في عبارتنا "نظام العصبيات".، وهذا في مدى الحقبة المعاصرة من تاريخنا. ولنعتبر استقلال 1943 بداية لها واندلاع الحرب سنة 1975 حدا فاصلا بين مرحلتين تستغرقانها.
نقول "عصبيات" – لا عصبية واحدة – لأن المجتمع اللبناني يدخل في تكوين نظامه السياسي وفي معايير السلوك السياسي فيه عصبيات ثلاثا رئيسة. وهي 1- عصبية القرابة، وإن تكن القرابة اسمية لا غير: أي مقتصرة على الانتماء إلى عائلة أو عشيرة أو على المصاهرة البعيدة من غير احتساب – بالضرورة – لدرجة القربى الفعلية أو مستعاضا عنها بمجرد الحلف بين العائلات أيضا. 2- عصبية الجهة أي القرية أو الحي في المدينة أو في القرية أو الإقليم أو مجموع القرى المتقاربة يضمها شيء من التعارف والتعامل بين أهاليها. 3- العصبية الطائفية، وهي قد تتدرّج، في بعض ظروف المواجهة الحادة، على الخصوص، من المذهب إلى الديانة. ويشقّها، عادة تداخلها مع العصبيتين الآنفتي الذكر أو مجرد الخلاف في الاجتهاد المتصل بصوالح الطائفة... أو يرعى شقّها الاستقطاب الخارجي أيضا.
وقد كان يوجد، حتى عشايا الحرب، شيء من التكافؤ بين هذه العصبيات الثلاث. وكان يعزز هذا التكافؤ أن النظام يعترف، في الدستور وفي قوانين وأعراف مختلفة، بفاعلية سياسية للثانية وللثالثة منها. هذا فيما تبقى فاعلية الأولى أمرا واقعا أو تصح نسبة جانب منها إلى العرف أيضا. وكان مؤدى التداخل أن تتواجه زعامات جهوية في الطوائف وأن توجد أحلاف عائلية أو جهوية عابرة للطوائف وأن تخرج قوى سياسية ذات شأن من الأسر العصبي كله مستفيدة من التشقق المستشري في العصبيات كلها... إلخ. والحق أن هذا التشقق لم يكن متساوي الأثر في سائر الطوائف ولا في سائر الجهات والمنظومات القرابية. فكان الخروج السياسي على العصبيات ينال من طائفة – مثلا وخصوصا – أكثر مما ينال من غيرها. ولهذا أسباب تاريخية، مؤسسية وسياسية، ليس هذا مجال التفصيل فيها. فيكفي التنويه بأن التفاوت المذكور كان لا يلبث أن يردّ قدرا من هذه العصبية أو من تلك إلى التشكيلات الخارجة على العصبيات الثلاث جميعا. ذاك نكوص كان يلج أبوابا مواربة ويسلك قنوات متعرّجة تعصى على الحصر. فكنّا نقع – مثلا وخصوصا – على أحزاب علمانية تتبدّى في تكوينها، أفضليات طائفية واضحة – وإن تكن، في صورها العامة – متنوعة المنابت الطائفية. وهذا فضلا عن الأفضليات الجهوية وحتى القرابية. غير أن التكافؤ النسبي بين العصبيات كان يبقى في ما يتعدى هذا التشابك في تشكيل القوى ( أو هو كان يبقى بسبب هذا التشابك، جزئيا) واقعة من الوقائع الثابتة.
في المرحلة الثانية – وهي تغطي العقود الثلاثة الأخيرة تقريبا – مالت العصبية الثالثة، أي الطائفية، إلى الاستيلاء على الثنتين الأخريين: بالكسر والخلع حينا وبالمزج بين الترغيب والترهيب أحيانا. وكان الترهيب من طبيعة الحرب. ولكن الترغيب كان ماثلا بقوة بين ما تفتقت عنه الحرب من ممكنات. ثم اتسعت موارد الترغيب بعد الحرب من غير أن يهن عصب الترهيب كثيرا. لم يبق الخوف على الحياة نفسها صورة بارزة للرهبة. ولكن بقي الخوف على الحرية وعلى الأرزاق ومختلف المصالح. دخلت الطائفية إلى أحرام للعصبيتين الأخريين مطيحة استقلالهما النسبي عنها بمعظم مجاليه، مدمّرة بعض نسيجهما ومسخرة بعضه الآخر لإحكام شبكاتها المنتشرة على مدى البلاد طولا وعرضا. ولا نقول "شبكات" اعتباطا. فإن الكتل المتراصة من الطوائف الكبرى موجودة اليوم، بأجسامها، في بيروت الكبرى (وقد يصح أن نضيف المهاجر). ولكن وجودها السياسي منشور بتوسط قانون الانتخاب وأعرافه، على الخصوص، حتى أطراف البلاد. فهي عادت شيئا غير الكتل المنفصلة التي كانتها في ما مضى: المنفصلة حسيا والمنفصلة سياسيا، على الأغلب. عادت شبكات بمعنى الكلمة التام، شأنها شأن الإنترنت (ولا ضير من المبالغة هنا). وارتدّ ما كان لها – عبر القرون – من قواعد جغرافية إلى قواعد شبه رمزية. فهي، في معظم الحالات، قواعد قائمة في السياسة وبالسياسة، قبل كل اعتبار، وإن تكن الاعتبارات الأخرى كثيرة وغير هيّنة الأثر.
من يتولى تدبير الحرب؟
ما علّة استتباب هذا الاستيلاء الذي نحا نحو اختزال العصبيات في واحدة؟ علّته هي الحرب نفسها وظروف عشاياها ونظام غدواتها. فمن بين تشكيلات المجتمع اللبناني، كانت الطوائف – لا العشائر والعائلات ولا المناطق – هي الأولى بتدبير الحرب الأهلية. وكان عدوان الطوائف على العصب القرابية والجهوية، وهو ما استوى قواما بارزا للحرب بين كسور كل من الطوائف المتقاتلة، إبراما عمليا لحق الطوائف في تدبير الحرب الأهلية والتعبئة لها وسياسة ما بعدها أيضا. ولا يحتاج إلى فضل بيان ما كان في الحرب اللبنانية من جسامة للصراع في صفوف كل من الطوائف المتواجهة حينا والمتحالفة حينا آخر. ولكن هذه الجسامة بعيدة جدا عن الصلاح نقضا لدعوى طائفية الحرب. فإنما هي نقيض هذا تماما أي الدليل الساطع على ما كان للمعطى الطائفي من مكانة كبيرة في الحرب وعلى الصفة الأهلية لهذه الأخيرة. وهو دليل لا يمنع قطعا أن يكون للحرب – حين ينظر إليها من زاوية أخرى – صفة أخرى.
الجلوس غير المأنوس
ما شأن هذا كله بالفساد؟ هو شأن جسيم أيضا. ولقد أجاد محمد فريد مطر حين تلبّث كل هذا التلبّث ( في مقالة ألمعية تضمّنها كتاب صدر قبل أيام1) عند تجذّر الفساد ( بتجلّيه الراهن، على الأخص) في طائفية النظام السياسي الاجتماعي. كان الفساد منتشرا قبل الحرب ولكن صيغته كانت مختلفة عما هي عليه اليوم. وهذا باختلاف صيغة العلاقات ما بين العصبيات الفاعلة في المجتمع اللبناني. في الحرب، استحكمت الطائفية وطغت على المسرح العصبي. فكانت الراعي اليقظ للفساد الفادح فضلا عن رعايتها عنفا هو الغريزة في السياسة وهو سياسة الغريزة، وعن توسعها في سائر الموبقات. بعد الحرب، صدر عفو عام. وقد لا تستقيم المجادلة في وجاهة هذا الإجراء. ولكن العفو العام، أيام كان يصدر، في أعياد الجلوس المأنوس، عن مجرمين عاديين أو مجرمين فوق العادة، كانوا يرسلون آمنين إلى بيوتهم ولا يسلّمون مقاليد الدولة والبلاد. العفو عندنا كانت له سيرة أخرى.
كيف إذن، بعد فساد الحرب كله أو بعد الحرب بما هي فساد للسياسة وللحياة الاجتماعية برمتها، ينتظر من رعاة الطوائف في أدغال الحرب أن يكونوا المصلحين في السلم وأن يمحقوا جراثيم الفساد المنتشرة في المجتمع؟ ما حصل هو ما كان مقدّرا له أن يحصل. وجد أقطاب رحى الحرب شركاء لهم مناسبين وكانت الشركة الجديدة شركة بين السطوة والمال. وهي لا تمنع التنازع بين الشركاء أبدا ولكنها تحملهم على الاعتبار، كلما اشتد الوطيس، بحاجة الواحد منهم إلى شركائه. وهي تحملهم أيضا على التماس الحماية الخارجية ممن يقدر عليها وعلى رعاية موازينها بينهم طالما استمرت في رعاية موازينها معهم، على الأقل. فإن لقاء المال والسطوة استثمار متبادل. وإن من التعريفات الموافقة لمناخ الفساد – في ما نحسب – أن يصبح المال غاية أثيرة لأصحاب السلطة وتصبح السلطة غاية أثيرة لأصحاب المال. ولا اعتبار – مرّة أخرى – بالتنازع . فهو، شأن العراك بين القبضايات في المقهى، يتضرر منه أصحاب المقهى والزبائن أولا. وأما المتعاركون فلا يجاوزون – في الأعم الأغلب – أن تبحّ أصوات بعضهم أياما تطول أو تقصر.
الدولة والعصبيات: حال جديدة
ما الذي كان يعنيه أن تكلل الطائفية هذا الحلف المتنافر من ذوي السلطان الجدد؟ كان معناه حالا جديدة للدولة بعد الحرب قياسا على ما كانت عليه حالها قبل الحرب. فقد كانت إحدى السمات المهمة لدولة الاستقلال أن تستوعب العصبيات المتلاقية في مؤسساتها شيئا ما بحيث يلطّف بعضها بعضا ويجد الجمهور، بسائر انتماءاته، إلى تضاعيفها منافذ متنوعة. ولم يكن نادرا – وإن بقي محصورا – أن تنشأ، في رحاب مؤسسات الدولة، دوافع وفرص لتجاوز العصبيات الأولية جميعا في السياسة وللانتقاض الموضعي عليها. كان بعض من هذا يحصل في التعليم الرسمي – وفي الجامعة اللبنانية، بخاصة – وبعض منه يحصل في الإدارة العامة وبعض في القوات المسلحة. وقد تشكلت من هذه النوازع قاعدة لمرحلة من مراحل الحقبة السابقة للحرب هي المرحلة الشهابية. وتحقق، بفضل هذه النوازع أيضا، انتشار لا يستهان به ليمين ويسار علمانيين، وجدا جانبا كبيرا من قواهما في صفوف صغار موظفي الإدارة العامة ومعلمي القطاع الرسمي وطلابه وتلامذته. تبدلت هذه الحال في الحرب وبعدها إلى تقاسم أقطاب الطوائف المرعيين من خارج قائم في الداخل، لا سلطة الدولة وحدها بل مؤسساتها أيضا بما فيها مؤسسات الخدمة العامة والجامعة والمدارس. كانت الدولة، قبل الحرب، مسرحا لغلبة متفاوتة الحضور والأثر، متنوعة المراجع. فانتهى بعضها، غداة الحرب، إلى إقطاعات فعلية، محيّدة نسبيا عن التنازع بنعمة الاعتراف المتبادل. وانحصر التنازع في مساحة مركزية لا مجال للسيطرة المنفردة عليها ولا مناص من النظر المشترك في ما يدار عليها من شؤون. لم ينحسر الإقطاع السياسي إذن، بعدما انفصل كليا عن الأرض. فإنما نحن اليوم حيال أصرح تكريس لهذا الإقطاع عرفناه في تاريخنا المعاصر. أخيرا بدّدت دولة ما بعد الحرب معظم ما كانت الدولة قد جمعته، في الحرب، من رأسمال عاطفي. فخلت قلوب اللبنانيين من توق إلى الدولة، في إبان تداعيها، هو الذي حمل محمد العبد الله (وهذا شاعر لم يؤثر عنه التعلق بالسلطة الرسمية) على أن يجعل عنوان واحد من كتبه حبيبتي الدولة.
التنظيمي والهيكلي
ولا أعود إلى السؤال: ما شأن هذا كله بالفساد؟ فهذا كله باب الفساد ومحرابه. حين توزّع مؤسسات للسلطة العامة وأخرى للخدمة العامة قطائع قطائع، نكون قد انتقلنا إلى ضرب من استخصاص العام هو التعريف الأوثق للفساد أو هو الفساد نفسه.
هذا الفساد، بما هو حالة سياسية أصلا، فساد طائفي، قبل كل شيء. وهو، على هذا، هيكلي. فليس هو بالفساد التنظيمي أو القانوني، من حيث الأساس. نقول هذا من غير إزراء – ولا بأس من التكرار – بالجانب التنظيمي القانوني من الفساد ولا غفلة عن أن مكافحته محتاجة أشدّ الاحتياج إلى تجديد الأنظمة والقوانين وتعزيزها. نقول إنه طائفي لأننا نرى المضي في تقديم الموازين الطائفية على أنها الموازين المتصدرة للشؤون العامة، بالضرورة، عقبة كؤودا، لا دون الإصلاح نفسه وحسب بل أيضا دون تكوين قوى مرموقة فاعلة، في قواعد المجتمع وفي قمم السياسة وفي ما بينهما، تطلب الإصلاح حق طلبه ويكون في مستطاعها أن تفرضه.
وذاك أن التقاسم الطائفي تجاوز الدولة إلى ما لا يزال يسمّى ظلما مؤسسات المجتمع المدني، وأدرجها – ولو على تفاوت – في شباك الفساد المعمم. فهذه المؤسسات (بما فيها ما يدار منها بعقلانية مؤسسية مقبولة) تنبري لحماية الفساد بالذود عن الحصص الطائفية، حين لا تضلع، هي نفسها، في فساد نفسها وفي فساد الدولة. انحسرت الأحزاب غير الطائفية واستتبعها نظام الطوائف. وخلفتها تشكيلات سياسية طائفية كبرى. وتوزعت أهم مرافق الإعلام بين أقطاب الطوائف. وأمست المراجع المذهبية عيونا ساهرة (معترفا بحقها في السهر) على الموازين المعهودة، في كل موقع ومجال. ليس مرادنا، بالطبع، أن نغض الطرف عن سعي الطوائف، بعضها إلى دفع بعض نحو هوامش المجتمع والنظام. تلك – أي التهميش الجزئي – حال قائمة لا يغيرها بلوغ السلطان الطائفي أوجه. وينعم السعي إلى إدامتها برعاية الجوار السامية. مرادنا أن لبّ السعي إلى تقليص دوائر الفساد يجسده السعي إلى تجاوز القاعدة الطائفية أصلا لإدارة المجال العام وتنميته.
إغراق السمكة
يشدد محمد فريد مطر، في المقالة المشار إليها، على زواج المقت التاريخي بين اللبنانيين وسلطة الدولة ونزوعهم بالتالي إلى اتخاذ المال العام سلبا والزوغان من أداء أنصبتهم منه وإلى إهمال الصالح العام أو العدوان بأطماعهم عليه. ويرى مطر في هذا كله علّة تاريخية للفساد. ذاك تعليل لا يجوز الاكتفاء به (على وجاهته في دائرته) ولا يكتفي به كاتب المقالة، في كل حال2. وقد كان، في الآونة الأخيرة، أن نفرا من مثقفي الصيغة "الفذّة" أو "الفريدة" عندنا (وهم، عادة، من مدمني إغراق السمك) فطنوا إلى المحسوبية. وارتأوا، مترجمين عن الفرنسية أو الإنكليزية، أن يطلقوا عليها اسم "الزبائنية"، وكأنهم لم يسمعوا لبنانيا قط يقول لآخر: "محسوبك أنا، يا ريّس!"3. هذا أمر عارض هنا، في كل حال، أوردناه حتى لا يظن أننا نترجم فسادنا كله عن لغة آخرين! ولا ريب عندي في أن المحسوبية ركن ركين للفساد في قطاع الدولة وفي ما يفيض عنه. ولكن نسبة الفساد اللبناني إلى المحسوبية، من غير مزيد من التحديد، يشبه نسبته إلى "الطبيعة البشرية" على إطلاقها. أي أننا ننتهي، مرة أخرى، إلى إغراق السمكة4.
وحقيقة الأمر أن المحسوبية، في لبنان، لم يكن لها قوام قط من غير مرتعها العصبي الخصيب. وهي كانت ترتعي العصبيات كلها في مرحلة ما قبل الحرب. وحين نحت الحرب نحو اختزال سائر العصبيات في الطائفية (وهذا اختزال لا يسعه أن يصبح مطلقا) باتت المحسوبية ترتعي العصبية الطائفية وما يليها من تقاسم الدولة ومرافق المجتمع الأهلي (وما هو بالمدني) قبل أي مرعى آخر. فهي، من الأسفل، ما هو إقطاع اليوم السياسي من الأعلى. لا يصح إذن أن تتخذ المحسوبية درأة للطائفية من النقد ومن مساعي الإصلاح. هذا قول راهن في جدل راهن. وإنما وجاهة الكلام في المحسوبية إبرازه تمتع الفساد – عبر التقاسم الطائفي المشار إليه وما يتبعه من شراء للولاء السياسي – بقاعدة شعبية عريضة. وهو – أي هذا التمتع – ما يفضي بنا إلى كلام قليل بقي أن نقوله في ما سميناه "كلفة ثانية" أي في كلفة الفساد السياسية حصرا.
لحس المبرد
في مستوى "القواعد الشعبية" للفساد، يزيد اعتبار هذا الأخير سبيلا معبّدا للانتفاع الفردي والجماعي، في ما يتعدى القانون، وللنجاة من الواجبات العامة، على اختلافها، وللوجاهة وعلو الكعب الاجتماعي أحيانا، من ميل اللبنانيين إلى الإشاحة عن الصالح العام وإلى اللامبالاة بالسياسات العامة التي تطول إليهم بالضرر، بما هم جماعة وطنية، وإلى الاكتفاء بمداراة ما نالهم من أضرارها أشخاصا وعصبا ضيقة أو ما طاول أنصبة طوائفهم من المنافع العامة. فأين هي، مثلا – وهذا مثل الأمثلة – مواقف اللبنانيين المناسبة، في سعة التعبئة وفي الفاعلية، لنمو الدين العام هذا النمو المشبوه في مدى خمسة عشر عاما؟ وكيف لا يلتفتون، على الأخص، إلى أن معظم هذا الدين، اليوم، فوائد متراكمة لم تنفق على شيء أو أحد في البلاد، ولو على سبيل الهدر؟! ما بالهم إذن لا يسألون: "كيف كان ذلك؟" هم يتوجسون كثيرا من هذا الدين ولكنهم لا يتناسون في سرّهم – حتى الآن – ما استقر في جيوب شرائح عريضة جدا منهم من فتات المال المهدور: تعويضات قبضت من غير وجه حق وتوظيفا تمّ لبعضهم من غير حاجة عامة إليه وإغضاء عن مخالفات وجنح بالغة التنوع وتهاونا في مطالبتهم بواجباتهم في الوظائف بحيث تيسر لهم الانصراف إلى غيرها،... إلخ. يتحدث اللبنانيون كثيرا في فساد الكبار ويعرفون عنه الكثير. ولكنهم يباركونهم، في الانتخابات، بعشرات الألوف من أصواتهم ويذكرون لهم جودهم عليهم – في ما عدا الإنعامات الفردية – بطريق عبّدت هنا على غرار السعتر بالزيت أو بمدرسة لا حاجة إليها أبعد من سرقة ثلثي الاعتماد المخصص لبنائها أو بشبكة مجارير تنتهي سائحة في البراري والقفار وترتدّ، على غفلة منهم ، إلى مياه الشرب.
هذا كله (وغيره مما هو أدهى منه) يسكت عنه اللبنانيون، خاصة وعامة، أو يثرثرون فيه كثيرا، بالأحرى، ولا يكون لثرثرتهم ما بعدها. هم يلحسون دمهم ويستطيبونه ويرفعون إلى السماكين من يرون أنهم يجودون عليهم بلحسه.
هذا الخذلان العام يبعد أفق الإصلاح. هذا أقل ما يقال. وهو هو اليوم، بأطره الطائفية وبما يحظى به من رعاية الخارج الذي في الداخل، ما يطلق عليه اسم الديمقراطية اللبنانية. وهذه ديمقراطية باتت تشبه الرقّ الطوعي أقرب الشبه. وليس الصالح العام مناط هذه الديمقراطية بل العجز العام وجراد الفساد المنتشر.
ينتهي هذا الخذلان إلى صورة عجيبة للتمثيل السياسي في هذه البلاد. وهي صورة كان خليقا ببشير الجميل أن يسمّيها "فريدة"، وهذا هو الاسم الذي كان ينادي به الصيغة اللبنانية، على ما يروى. في هذه الصورة، يظهر من يفترض فيهم إنفاذ القوانين (وهذه حال الحاكمين وسكان الإدارات) أو سنّ القوانين (وهذه حال النواب) رعاة مجتهدين لخرقها كل يوم، من جانب الأتباع، أو مبادرين إلى هذا الخرق، من جانبهم هم. بل إن وظيفة خرق القانون، في التصور الواسع الانتشار لتكوين الدولة ومؤسساتها، تتقدم بأشواط وظيفة الإنفاذ أو السنّ وهي هي عصب الولاء الأول وسببه. وهي تبدو مستندة إلى شرع آخر (أو إلى شرع نقيض) هو، في الحقيقة، مجموع من الأعراف يناوئ قوانين وأعرافا أخرى. وهو لا ينكر ما نسميه ها هنا فسادا ولا يستنكره وقد لا يعرفه باسمه هذا حين يراه. ذاك – بكل إيجاز – ما يصح وصفا عاما لكلفة الفساد السياسية في بلادنا هذه.
عمل التجريد السياسي
قبل نحو من عشرين سنة، أطلقت عبارة هي "عمل التجريد السياسي" على المساق الذي يستوي المواطن مواطنا، بمؤداه، وتستوي الدولة الديمقراطية أيضا دولة ديمقراطية5. وقد ضربت مثل اللبناني الداخل إلى إدارة عامة لإجراء معاملة ما دليلا على حال الميوعة الزائدة التي بقي عمل التجريد السياسي هذا يترنح عندنا فيها تائها في غمار العصبيات. وخلاصة المثل أن صاحب المعاملة والموظف المسؤول يتواجهان عندنا على أنهما إنسانان كاملان. أو لنقل – ما دام الحديث حديث الفساد – إنهما يتواجهان على أنهما إنسانان تامان. فإن الكمال لله، على ما هو معلوم. والمقصود بالتمام هنا أن كلا منهما يحفظ في وعيه أو على حافة وعيه، جملة الأبعاد أو الوجوه التي يتشكل منها بنو البشر. فإن كل شيء مهمّ في هذا المقام. مهمّ اسم الموظف وأصله وفصله وطائفته وما يعرف من سمعته، فضلا عن رتبته وحدود صلاحياته وطبيعة علاقته بسائر رؤسائه (ومنهم الوزير) أو أيضا بمراجع أخرى، رسمية أو حزبية، مدنية أو مذهبية، داخلية أو خارجية. ومهمّ، من الجهة الأخرى، منابت صاحب المعاملة، على اختلافها، ومكانته الإجمالية وثروته. ومهمّ طبعا ولاؤه السياسي ودرجته في الشبكة التي يدرجه فيها هذا الولاء. ومهمّة طبيعة المزيج الذي يتحصل من تداخل هذا كله مع ما يقابله عند الموظف. ومهمّ، أخيرا، وجود مخالفة أو خلل ما في المعاملة أو استقامة أمرها. ولكن هذا العامل الأخير كثيرا ما يكون أدنى أهمية بكثير من سابقاته حين يدخل في سلطة الموظف عنصر الاعتباط. ففي مستطاع الموظف إذ ذاك أن يجد الخلل أو المخالفة من طريق التأويل والاجتهاد وما يليهما من تعجيز. وقد يأنس من نفسه القدرة على تأخير البت إلى ما شاء الله أو على التقدير المبالغ فيه لرسم مطلوب أداؤه إذا كان هذا الرسم خاضعا للتخمين لا مقطوعا. يمكن أن تفضي المواجهة الشاملة هذه إلى إجراء المطلوب من غير كلفة مادية ظالمة تقع على صاحب المعاملة. وذلك سواء أوجد الخلل والمخالفة أم لم يوجدا. ويمكن أن يحصل البت سلبا من غير أمل لصاحب المعاملة في نقض للقرار لا تتيحه جملة أوضاعه. ويسع النفوذ، من جهة طالب الخدمة، أن يكسر استقامة الموظف المستقيم. ويسع طلب المال من جهة أو عرضه من الجهة الأخرى أن يمهد عقبات كثيرة، شرعية كانت أم غير شرعية، وأن يدرأ ضررا تلوح أشباحه في موقف الموظف الفاسد. صفوة القول أن كثرة العوامل والاعتبارات المتدخلة في هذه العلاقة المؤقتة تفتح أبوابا أمام الاحتمالات كافة. وليس المسلك القانوني مقرونا بالإنصاف العملي، من الجهتين، إلا واحدا من هذه الاحتمالات وقد يكون أضعفها.
ذاك موقف يعرض عندنا كثيرا في كل يوم. ويقع جانب من المسؤولية عنه على الأنظمة التي تترك السبل سالكة أمام الاستنساب والاعتباط. فيجب إصلاح هذا الخلل في موضعه أي في الأنظمة. ويقع جانب من المسؤولية نفسها على القصور الحاصل في عمل التجريد السياسي. فهذا عمل يفضي، حين يكتمل، إلى إبعاد كل العوامل التي يتمخض عنها الإنسانان التامّان (وقد سبق تعدادها) باستثناء عامل واحد هو الصادر عن صفة المواطنية. ومعنى الاقتصار على المواطنية ها هنا أن يتواجه مواطنان وحسب (لا إنسانان تامّان) يطلب أحدهما خدمة بما هي حق له باعتباره مواطنا لا غير، ويؤدي إليه الآخر هذه الخدمة بما هي واجبة الأداء عليه باعتباره مواطنا أيضا ناط به القانون هذا الصنف من أصناف الخدمة العامة.
في حاجة النفوس إلى النصوص
كيف نتقدم في سعينا إلى هذا التجريد الذي هو المرتكز الأعمق والأوثق للسعي إلى محاصرة الفساد؟ نتقدم بفعل ضروب شتى من الإصلاح أظهرها الإصلاح السياسي، وللخوض فيه( وفي غيره) مجالات تفيض كثيرا عن نطاق هذه الكلمة. في هذه الكلمة، شدّدنا على كون العمق الذي تضرب في مشكلة الفساد جذورها لا يعفينا من النظر في إصلاح أقرب متناولا هو إصلاح القوانين والأنظمة، ومعياره – فضلا عن الإنصاف – تعزيز المحاسبة والشفافية. ولكن التفصيل في هذا الضرب من الإصلاح لا تحتمله كلمة موضوعها الكلفة السياسية للفساد. ذهبنا إلى مزيد من التشديد أيضا على إصلاح آخر، أبعد غورا، مداره السعي إلى فصل السياسة والدولة عن عصبيات المجتمع الأولية. وقد توحي هذه المقاربة بالتعويل على عمل تربوي لا نهاية منظورة له ولا ضمان لإثماره. فكأننا عدنا إلى تقديم النفوس على النصوص! لا ننكر أصلا خطر ما في النفوس ولا وجاهة التربية بمعناها الأشمل. ولكن ثمة نصوصا يجب وضعها وإنفاذها من غير مراوغة ولا تخاذل. ثمة إصلاحات لا محيد عن المضي بها نحو غاياتها. وأهم هذه الإصلاحات مضمّن في الدستور نفسه وفي اتفاق الطائف، فلا يسع اللبنانيين القول إنهم يقفون أمام ضرورتها لأول مرة.
هل يريد اللبنانيون هذه الإصلاحات؟ هل هم متوافقون عليها فعلا؟ أم أن جمهورهم باق على استطابته لحس المبرد حتى تقع الواقعة؟ جعلنا عنوان الكتاب الذي تضمن مقالة محمد فريد مطر الآنفة الذكر "خيارات للبنان". وتضمن الكتاب نفسه مقالات أخرى أوصت بإصلاحات لم تكد تدع بابا كبيرا للإصلاح إلا ولجته. وبين هذه المقالات واحدة لنا تعفينا من العودة هنا إلى تعداد عناوين الإصلاح المنشود، وقد اخترنا لها عنوانا: "الطائفية: ملامح لإصلاح معلن"6. وعلى رغم أن عنوان الكتاب "خيارات للبنان"، زعمنا في المقالة المشار إليها ( ونعود إلى الزعم هنا) أن لا خيار للبنانيين في أمر الإصلاح وأن الأوان قد فات، من مدّة غير قصيرة، على إمكان المراوغة والتسويف فيه. فعسى ألا يكون أوان الإصلاح نفسه قد فات.
أواخر حزيران 2004