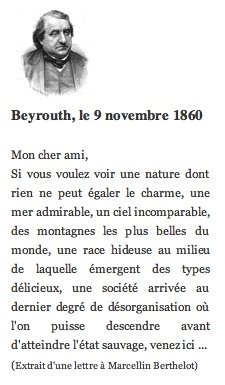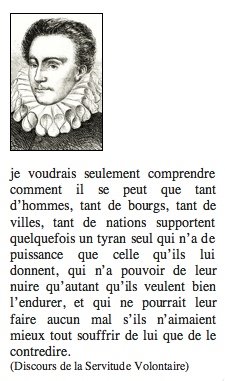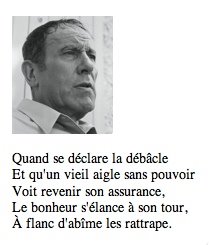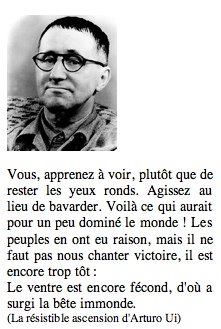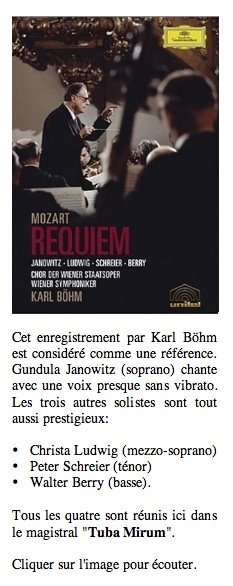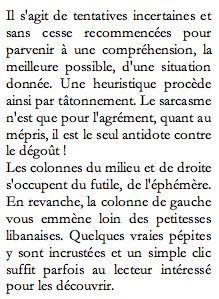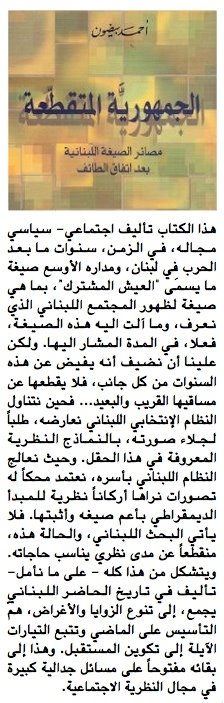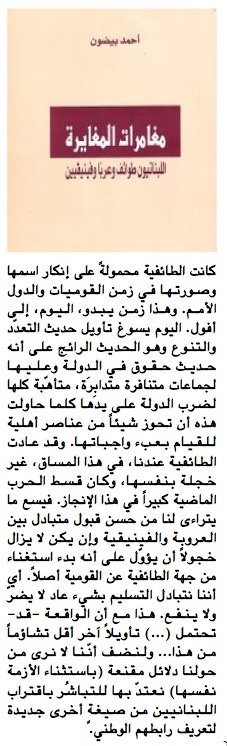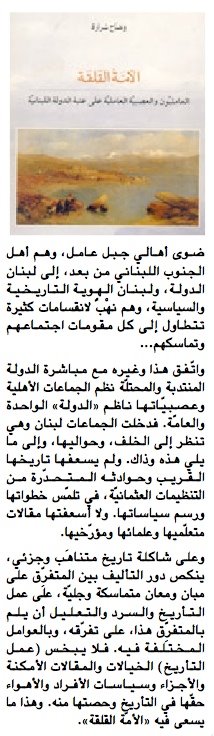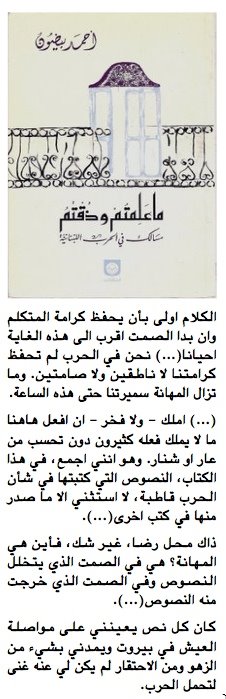La "formule", le pacte et la Constitution
الصيغة، الميثاق، الدستور
لبنان الطائفي بين ديمقراطية وسلام
أحمد بيضون
لبنان الطائفي بين ديمقراطية وسلام
أحمد بيضون
آثرت الإعراض عن الدخول في جدل نظري بحت مع المطالعة المحكمة التي وضعها بين أيدينا آلان كاييه. فقد لا يترك لي ما تتسم به هذه المطالعة من إحكام سبيلا إلى المجادلة أو قد لا أكون مؤهلا أصلا لولوج هذا السبيل.
عليه اخترت أن أنظر في ما إذا كان للتجربة اللبنانية أن تقدم إسهاما في جهد الإجابة عن سؤال كاييه المتصل بأهلية الديمقراطية لدرء النزاعات.
والمراد بالنزاعات، في هذه الحالة، ما كان منها داخليا أولا. أي أننا نعرض، من خلال الحالة اللبنانية، للعلاقة ما بين الخيار الديمقراطي والسلم الأهلي. ولكن دروس هذه الحالة تفيض، في الواقع، عن نطاقها الداخلي. فقد عرف لبنان نزاعات متعددة الأبعاد كان آخرها أطولها مدة وأفظعها حصائل. وقد اندرج هذا النزاع في مواجهة إقليمية عمل بعض أطرافها مباشرة على الأرض اللبنانية وعمل بعضهم من خارج هذه الأرض. وكان لهذه المواجهة، في تجلياتها اللبنانية، بعد دولي مؤكد وصل إلى حد الدخول العسكري لأطراف دولية إلى لبنان أيضا، بدعوى فض النزاع، ووصل أيضا إلى حد استهداف هذه الأطراف مباشرة من جانب خصومها، في النطاق اللبناني. واستمرت بعد انكفاء العنف الأهلي حرب مقاومة للمحتل في جنوب البلاد، وهي حرب ما برح بعض مفاعيلها من إقليمية ودولية وما برح أيضا ما يلي هذه المفاعيل من عواقب يرزح ظلها على البلاد، واقعا قائما إلى اليوم. وهذا كله فضلا عن استواء الحالة اللبنانية، مدة الحرب، مدارا سياسيا من مدارات الصراع بين الدول الكبرى في تلك المرحلة.
عليه فإن السؤال الذي يتناول السلام الأهلي في صلته بالديمقراطية ينطوي أيضا، من حيث المبدأ، على سؤال عن الصلة بين نوع بعينه من "الديمقراطية" – هو المعتمد في هذه البلاد – وبين حظوظ السلام الإقليمي وما يليه من آثار في الساحة الدولية.
هذا وينطوي اختيارنا هذا المدار لبحثنا على أمر آخر. ينطوي على الرغبة في إبراز الأساس الاجتماعي الذي يصح افتراض ضرورته للديمقراطية. وهذه مسألة تتعدى مجرد السؤال عن درجة النمو الاقتصادي المناسبة للديمقراطية، إذا جاز افتراض مناسبة من هذا القبيل. فهي تتناول صفة التشكيلات الغالبة على المجال العام. وهذه يحتمل أن تكون دواعي غلبتها متشابهة بين مجتمعات غنية وأخرى فقيرة. وهي – أي مسألتنا – تضع على المحك إمكان فرض الديمقراطية مع افتراض كفالتها للسلم الأهلي، بخاصة، بقوة القوانين المناسبة وحدها. هذا ناهيك بإمكان استيرادها على عجل من وراء البحر استجابة لإرادة خارجية ما.
الأثافي الثلاث
في لبنان، تعتمد مراجع ثلاثة للحكم على التصرفات السياسة أو لها: الدستور الميثاق، الصيغة. ونحن سندير معالجتنا للمسألة التي طرحنا على استكشاف شبكة الصلات التي نسجها تاريخ لبنان المعاصر بين هذه الأقانيم الثلاثة. هذا ولا نعدّ اتفاق الطائف رابعة الأثافي، لا غضّا من شأنه وهو قد رعى خروجنا من الحرب، بل لتقديرنا صورة بعينها لعلاقته، نصا ثم تطبيقا، بأركان الثلاثي الآنف الذكر. فما نراه هو أن الاتفاق كان، في تصوره مرحلة انتقالية رسم معالمها، تعديلا للصيغة اللبنانية قضى به تبدل الأحوال عبر تاريخ لبنان المستقل. وكان أيضا تعديلا للميزان بين مقولتين تقابلتا في الميثاق ويأتي ذكرهما عما قليل. ثم إن اتفاق الطائف افترض للنظام اللبناني طورا ينتقل إليه عبر هذه المرحلة الانتقالية وهو طور اللاطائفية من جهة الصيغة وجلاء القوات السورية عن لبنان من جهة الميثاق. وحين لم يحصل هذا ولم تتحقق تلك استحال تعديل الصيغة فضيحة لها وتعديل الميثاق انحطاطا بالميثاق إلى الكذب. ثم إن مساق الإصلاح الذي انتقل من الاتفاق إلى الدستور قصّر عن تحسين للدستور كان يبتغيه لأن خطا خطوة أولى ووقف بعدها فأفسده تجميده واللعب المنفرد بمندرجاته وعزله عن بيئة وفاقية افترضت له في الاتفاق. فالذي كان ينبغي له أن يستوي مسيرة اقتصر منه على دعسة ناقصة. هذا ما كان.
فإذا عدنا إلى ما نحن بصدده مبتدئين بالميثاق الوطني – وهو الذي يطلق اسمه على ما جرى من اتفاق بين أول رئيس لجمهورية لبنان المستقل وأول رئيس لحكومته في عشايا الاستقلال – كان علينا أن نلاحظ أن المضمون الصريح لهذا الاتفاق لا صلة له بطبيعة النظام السياسي: أيكون ديمقراطيا أم غير ذلك؟ فمضمون الميثاق الصريح ترك المطالبة بالوحدة العربية (أو السورية) من جانب من اللبنانيين وترك المطالبة بالحماية الأجنبية من الجانب الآخر. غير أن الميثاق ، بما هو عقد، يرتدّ، ضمنا، إلى إيلاء مقام هو مقام تأسيس الدولة المستقلة لأطرافه. وهذه الأطراف هي الطوائف اللبنانية، ضمنا أيضا. هذا الاستواء للطوائف، حصرا، أطرافا في تأسيس الدولة المستقلة يفضي إلى شيء غير الميثاق ( وغير الدستور الذي سيأتي ذكره فورا) هو ما يسمى الصيغة اللبنانية، وهي، من وجه ما، أسبق عهدا من الدستور ومن الميثاق.
أما الدستور فهو، من حيث الأساس، في وارد غير وارد الصيغة الطائفية. هو يرسي جمهورية برلمانية عادية: من مجلس النواب المنتخب لمدة محدودة إلى الحكومة التي تحكم بثقة هذا المجلس إلى رئيس للجمهورية منتخب من جانب المجلس ولا تجدد ولايته وتحد صلاحياته (بعد تعديل 1990 على الأخص) مؤسسات وأصول صارمة أظهرها مؤسسة مجلس الوزراء الذي عاد رئيس الجمهورية لا يسمي رئيسه إلا بنتيجة استشارات نيابية ملزمة. هذا وليس للرئيس من سلطة مباشرة على الإدارة العامة ولا على القوات المسلحة ولا، بالطبع، على القضاء. في الدستور، على صعيد آخر، كفالة للمساواة أمام القانون وللحريات العامة الأساسية ولحقوق الأشخاص وحرياتهم. هذا كله يزكي التسليم بتوفر النظام على مقومات رئيسة للديمقراطية: الحريات العامة والخاصة، تداول السلطة، تولي المؤسسة المنتخبة مسؤولية التشريع ومحاسبتها السلطة التنفيذية، رقابة الحكومة على الإدارة بتوسط الهيئات المختصة وفي نطاق القانون، تبعية الأجهزة العسكرية والأمنية للسلطة السياسية، بل أيضا تزكية المبادرة الفردية والنظام الحر في مجال الاقتصاد، إلخ.. ولا يمنع هذا وجود مطاعن في كفاية الضمانة الدستورية لاستقلال القضاء وفي كفالة الدستور للشفافية في عمل الدولة وأجهزتها. ولكنها مطاعن لا تبطل غلبة التوجه الديمقراطي غلبة مؤكدة على الدستور اللبناني.
لا يبطل هذه الغلبة أيضا وجود منافذ محدودة في نص الدستور للصيغة الطائفية: المادة 95 التي كانت، في صيغتها القديمة، تنص على تقاسم طائفي لمقاعد الحكومة ولمراكز الإدارة، وهذا "بصورة مؤقتة والتماسا للعدل والوفاق"، ثم عدّلت سنة 1990، فحصرت التقاسم الإداري في وظائف الفئة الأولى وما جرى مجراها. وقد استعاض التعديل عن"الصورة المؤقتة" لمنطوق المادة بتوجه صريح إلى إلغاء الطائفية في الحكم وفي الإدارة حاصرا التقاسم المشار إليه في "المرحلة الانتقالية".
وأما طائفية النيابة فلم يكن لها أثر في الدستور قبل تعديل 1990. وإنما كانت تظهر في قانون الانتخاب. وهذا قانون ليست له، مبدئيا، حرمة الدستور، وكان قد خضع مرارا كثيرة لتعديلات كبيرة وصغيرة، ولكن المبدأ الطائفي في توزيع المقاعد بقي ثابتا فيه. وأما تعديل 1990 الدستوري، فجعل إعمال هذا المبدأ أمرا مؤقتا، بعد أن اعتمد توزيع المقاعد مناصفة بين طوائف الديانتين. عليه رتب على المجلس مهمة سنّ قانون للانتخاب يفكّه من القيد الطائفي.
من منافذ الصيغة إلى الدستور أيضا أن المادتين 9 و10 تكفلان للطوائف احترام نظام الأحوال الشخصية الخاص بكل منها مع سائر مصالحها الدينية وكذلك الحق في إنشاء المدارس. وليس في هذا مساس بالمبدأ الديمقراطي. إذ لا يفهم منه أن على أنظمة الأحوال الشخصية أن تكون طائفية حصرا ولا، بالطبع، أن إنشاء المدارس حق حصري للطوائف.
لا يكفي هذا كله – وهو بين "مؤقت و"انتقالي" وغير حصري – مطعنا في روح الدستور الديمقراطية. ولكن ديمقراطية الدستور لا تستنفد عناصر الإجابة عن حظوظ السلام الأهلي في الدولة التي يفترض أنها تحكم بموجبه.
هل هذه الدولة تحكم بموجب دستورها فعلا؟
أشرنا إلى أن "الصيغة اللبنانية" المكرّسة بافتراض الطوائف أطرافا لعقد الميثاق، إنما هي شيء مختلف جدا عن الدستور. وهي ترتد عليه وعلى الميثاق نفسه ثم على تماسك الدولة وعلى استقلالها، وفي ما يلي ذلك على سلام أهلي لا ترجّح حفظه. أي أنها تستحيل مرسى لنزاعات أهلية تخفق في درئها مع ما ينطوي عليه هذا الإخفاق من استدراج عوامل للاضطراب مصدرها النطاقان الإقليمي والدولي ومن عواقب تقع على البلاد وتنعكس منها على النطاقين المذكورين.
فما الذي تفعله الصيغة بالميثاق أولا؟ هي تبدد محتواه، في الواقع، على الرغم من أنها تستمد منه شرعيتها النظرية.
وذلك أن طلب الحماية الخارجية الذي حظره الميثاق عمّ لاحقا جهتي الميثاق عوض أن تقلع عنه إحداهما. وتحولت الحماية إلى حمايات لأن الجهتين، في واقع أمرهما، جهات. وكان الميثاق يفترض دورا موحدا للبنان في المساعي إلى تعزيز التضامن العربي. ولكن ما غلب، على الدوام، كان استجارة لأطراف لبنانية بهذا الطرف الإقليمي أو ذاك، عربيا كان أم غير عربي. وهذا على نحو يؤول عادة إلى تأجيج التنازع الداخلي لا إلى تعزيز التضامن العربي. وكان في هذه الاستجارة، عادة أيضا، تبديد لبعض مقومات استقلال الدولة. وهو ما يؤول إلى إضعاف سلطتها العامة في الداخل بما ينطوي عليه الإضعاف من تعريض للسلم الأهلي. فحيث تتفرق التبعيات ويتقلص مضمون الإجماع الوطني إلى نواته الدنيا، تسهل إطاحة السلم من الخارج، عند اللزوم، بتوسيط احتياط داخلي طيّع. وقد اتخذ الاستقطاب الخارجي، مع تهالك الدولة، في زمن الحرب، صورا صارخة. فتزودت أطراف الحرب أذرعا دبلوماسية تخاطب السفراء ويخاطبونها، بمعزل عن السلطة العامة، وتعقد مع الدول ما يشبه المعاهدات. على أن هذا النزوع لم يكن بدأ مع الحرب ولا هو انتهى بانتهائها...
الخلاصة إذن أن الصيغة التي جدّدها الميثاق ورسّخها زعزعت ما افترضه هذا الأخير من استقلال للدولة حيال الخارج وسيادة لسلطتها على الداخل. فكان أن استمرّت، وإن على تعثّر، حماية هذه الطائفة أو تلك من التهميش المفرط ( وهي حماية لم تنته، في أي وقت، إلى إنصاف عملي في التوزيع الطائفي للسلطة ولمنافعها). ولكن الحماية اقتضت مقابلا باهظا هو رهن السلم الأهلي (والسلم الوطني معا) إلى حد مفرط، بأمزجة الظروف المحيطة بالبلاد. فمنحت هذه الأمزجة، مرة أخرى، موارد داخلية لبنانية سريعة الاستجابة، سهلة التوظيف. هذا معطى لا تعسر صياغته في عبارة أخرى أقرب إلى غرضنا هنا. فنقول إن تجنيب الصيغة البلاد استبداد الفئة الواحدة ( وهو لا يمنع وجود قدر من الاستبداد في كل فئة على حدة)، لم يفض إلى إرساء استقلال عن الفئات لمصلحة وطنية جامعة، واضحة المعالم، تغلّبها سلطة عامة لها من السمو عن الفئات ما يقيها مغبة التفكك ويجنّبها الحاجة إلى الحماية الخارجية. فيتيسر لها، من بعد، أن تسوس المجتمع وتعالج نزاعاته بمقتضى ذلك التغليب للمصلحة المشار إليها.
ما الذي تفعله الصيغة بالدستور ثانيا؟
الدستور يكفل حقوق الفرد المواطن والصيغة تصادر هذا الفرد المواطن نفسه فتضمه، طوعا أو قسرا، إلى الطائفة التي هي منبته. تصادره في المهد وفي اللحد وفي الكامخ بينهما. وهي تضيّق بهذا، إلى مدى بعيد، من دائرة اختياره السياسي ومن حقوقه المدنية وتفرض عليه نظاما لأحواله الشخصية لا يوافق، بالضرورة، معتقده الشخصي. وهي تأذن، فوق ذلك، لدواعي المحيط الطائفي بالحدّ من حريته في توجيه حياته الخاصة. تلك حدود مقررة لحدود "الديمقراطية" اللبنانية من جهة حقوق الإنسان.
الدستور يقول بفصل السلطات. والصيغة تجعل محالا على رئيس السلطة التشريعية، أيّا يكن، أن يعفّ، بما هو رأس سياسي لطائفة، عن التدخل لمصلحة طائفته أو ما يهمه منها، في عمل السلطة التنفيذية. والصيغة تنذر بنصب رأسي السلطة التنفيذية، أيّا يكونا، أحدهما في وجه الآخر، على أنهما رأسان سياسيان لطائفتين، وبإدخالهما في تجاذب متكرر تراوح حصائله ما بين تأخير الحلول أو تجميدها وبين مقايضة قرار يرجّح هذه الكفة بقرار يرجّح تلك.
ينجم من ذلك كله أن السلطات التي يفترض الدستور لكل منها عمومية معبرة عن صفتها الوطنية، تتوزع بعض مرافقها، في واقع الحال، مواقع نفوذ. فيوكل إلى كل موقع منها السهر على تثبيت الولاء الطائفي لرأسه أو على توسيعه. وهذه حال تغري بالتوسع المتقابل في توزيع المنافع توسعا يضرب صفحا عن منطق المصلحة العامة وعن حدود إمكانات الدولة وعن سلّم أولوياتها المفترض. فيستشري الهدر والتوسع في توزيع المنن وسوء التنفيذ لأشغال يقصد من تنفيذها نفع الجمهور، طبعا، ولكن يقصد معه أو قبله انتفاع المنفذين و رعاتهم. يبقى لهذا كله حدّ واقعي – ولكنه مطّاط – هو حدّ إمكانات الدولة، بعد التوسع قليلا أو كثيرا في تقديرها. وهذا كله حدّ للديمقراطية من جهتي الشفافية والمحاسبة. فهل هو أيضا حدّ للسلم الأهلي؟ لا ريب أن الأزمة العامة، إذا عصفت، مضرة بالسلم الأهلي. ومتى ظهر أن حدّ إمكانات الدولة قد حصل تجاوزه من زمن بعيد، يرجّح أن يعمد قلائل إلى الخوض في محاسبة عامة. ولكن الذين حصل التجاوز لحسابهم، وهم كثرة، يرجّح أن ينحي كل منهم باللائمة على الجهة التي كان لها شريكا مضاربا بالأمس. ولما كانت الفواصل بين الشركاء طائفية أصلا، فإن كلا منهم سيستنفر من يذود عنه في وسطه الأليف. وأقل ما يقال في مثل هذا – وقد ظهرت له بوادر في الماضي القريب – أنه بعيد جدا عن المسالك المفضية إلى توطيد السلم الأهلي.
ينجم من هذين التجزئة والتناظر اللذين تحدثهما الصيغة في السلطات العامة أن من يتولى واحدة من هذه السلطات فيختار الدأب في تغليب المصلحة العامة – ملتزما، بذلك، ما يفترضه الدستور همّا وحيدا لهذه السلطات – لا يلبث أن يجد نفسه وقد جعلته الصيغة موضوعا لشبهة التفريط بحق طائفته. وهذه شبهة لا يحلو لساسة الطوائف، عادة، أن تلازمهم ملازمة متمادية. وذاك أن مصلحة الطائفة، في تجليها لمخيلة هذه الأخيرة، يندر أن توافق المصلحة العامة أو هي كثيرا ما تناقضها، في الأقل. فليس إلا مبالغة نسبية أن نقول إن مصلحة الطائفة، في أحلام جمهورها، هي أن ينجح تلامذتها جميعا في امتحانات المدارس وأن تخص أسرها جميعا برواتب من الدولة وأن يشملها إعفاء عام من الضريبة! هكذا تخفق الصيغة في تفريد سلطة الدولة، لخيال الطوائف، على أنها سلطة مخولة أن تعطي الحق وأن تفرض الواجب. عوض ذلك يستوي الحق، في الخيال المذكور، على أنه حق من الدولة ومنّة من رأس الطائفة الساهر على تحصيله، في آن. ويستوي الواجب على أنه مجرد عبء وسخرة، يفترض في الرأس نفسه أن يبعد كأسه عن شفاه أبناء الطائفة. فإذا صدع المسؤول بهذا التصور، دخل في صلب عمله تعطيل القوانين التي تمد يدها إلى جيوب الناس بالضرورة أو تقيد نزوعهم إلى الانتفاع من سبل يعدونها مناسبة لهم وإن تكن مخالفة للقانون. وهكذا يجد المسؤولون أنفسهم، على اختلاف المواقع، وقد أوكل إليهم، بحكم الدستور والقوانين، أمر بعينه، وأوكل إليهم، بحكم الصيغة، أمر آخر لا يندر أن يناقض سابقه. فهم، من الجهة الأولى، مكلفون تطبيق القوانين أو الإلزام بتطبيقها – وهذا ناهيك بسنّها أو إقرارها، في حالة النواب – وهم، من الجهة الأخرى، مكلفون السعي إلى تعطيل هذه القوانين نفسها حيث يضر تطبيقها بمصالحهم أو بمصالح أشياعهم. وهذا حين لا يجدون أنفسهم ملزمين بحماية من يخالف القانون وحتى بحضّه على المخالفة.
لهذا كله شأن خطير بمتانة السلم الأهلي أو هشاشته، وإن يكن، على الأرجح، شأنا غير ظاهر. فإن ضمور الولاء للدولة وضعف الإقرار لسلطتها بالسمو عن السلطات الأهلية المتداخلة أو المتقابلة وما يتبع هذين الضمور والضعف من تراخ عن اللزوم الطوعي لحدّ القانون، إنما ينتهيان إلى إضعاف قدرة الدولة على ضبط تصاعد النزاعات في المجتمع، على اختلاف مصادرها، وإلى إضعاف حيلة الدولة في مزاولة التحكيم بين فئات المجتمع وسياسة ما يمر به من أزمات.
صيغة معطّلة
أمر أخير هو أن الدستور افترض، من يوم إقراره سنة 1926، أن على الصيغة أن تتجاوز نفسها. وهذا أيضا ما افترضه البيان الوزاري لحكومة الاستقلال، وهو المعدود أقرب النصوص المكتوبة إلى التعبير عن مضمون الميثاق الوطني. والافتراض نفسه أكده ووضع له آلية محددة اتفاق الطائف والتعديل الدستوري الذي تبع إقراره غداة الحرب الأخيرة، وقد ذكرنا هذا. وفي ركاب كل من الأزمات الثلاث الكبرى التي أفضت إلى هذه النصوص، كانت الصيغة تتخذ صورة معدلة تضرب عرض الحائط بالنص الدستوري وسرعان ما تستقر معاملتها على أنها أبدية، أي على أنها ضمانة أبدية للوضع القائم. ولما كانت موازين هذا الوضع القائم كلها، من ديمغرافية واجتماعية-اقتصادية وسياسية، عرضة لتغير مطّرد يفرضه النزول على أحكام الحياة والتاريخ، فإن التناقض ما بين الصيغة الثابتة والموازين المتحولة كان لا ينفك ينمو باطّراد، محيلا الصيغة، من جهة تكيفها بحركة المجتمع، إلى صيغة معطلة، لا أكثر ولا أقل.
...والتناقض المذكور ينمو اليوم أيضا شأنه أمس. وكان تعديل الصيغة لتوافق، بعض الموافقة، صورة الوضع الجديد، ينتظر مرّة حربا عالمية ومرة حربا أهلية-إقليمية. والظاهر أن التسابق الحاصل اليوم في ترسيخ الصيغة و في مدّ أذرعها إلى دوائر جديدة من المجتمع، عوض السعي إلى تجاوزها وفقا للدستور، إنما يدل على رهن معالجة التناقض المشار إليه بحصول شيء من القبيل نفسه: حرب خارجية تعبث أصابعها بالداخل، أو حرب داخلية ينوب أطرافها عن أطراف الخارج ويحدّون من كلفة يرتّبها التناطح المباشر بين هؤلاء.
لا مراء في أن النظام اللبناني ينطوي على روادع لاستبداد فئة من فئات المجتمع بغيرها استبدادا مطلقا. وهذا مع أنه لا يستبعد قدرا من الهيمنة أو من التسلط، بل هو يستبعد أيضا معالجة هذا أو تلك بوسائل السياسة. فهو إنما يزكي الدفاع عن التسلط أو الهيمنة بقوة السلاح عند اللزوم. وهو يستجرّ لحماية هذه أو ذاك أو لمقاومتهما أحلافا خارجية تستجرّ بدورها ما يقابلها وتفضي إلى رهن الاستقلال. هذا إلى كونه يسفر عن دولة رخوة الأوصال، هزيلة الحظ من ولاء مواطنيها، تتقاعس الجماعات المتعايشة فيها عن حمايتها وتنشط كثيرا في حماية نفسها منها ومن غيرها. حتى أن هذه الجماعات تتوصل إلى مجابهة الدول الجبارة – إذا لزم الأمر – وتنتصر عليها. وهي تتواجه، أيضا، في ما بينها، عند الحاجة، وهذه حاجة لها في منطق الصيغة مقام محفوظ. هذا ما كان أمس وهذا ما هو كائن اليوم. ولكن استبعاد الاستبداد الداخلي، بصور له عرفنا منها حولنا أمثلة مهولة، إنما يبقى مزية كبرى، وهي مؤكدة للنظام اللبناني، أو – إن اخترنا الدقة – للصيغة اللبنانية. فهل تكفي هذه المزية حتى يعدّ هذا النظام ديمقراطيا؟ وما دام مدار حديثنا على كفاءة الديمقراطية في حفظ السلام، فإننا متى طابقنا ما بين ردع الاستبداد والديمقراطية، مجيبين بالإيجاب عن سؤالنا اللبناني، كان علينا أن نخلص إلى أن صيغة الديمقراطية اللبنانية لا تدرأ المنازعة العنيفة بين ظهرانينا بل تبقيها احتمالا مفتوحا ولا تني تسوقنا نحوها. ثم إن هذه الصيغة نفسها لا تعزز حظوظ السلام في محيطنا الإقليمي بل تغري كثيرا بخلخلة الأمن فيه، عند اللزوم. ومهما تكن مرارة الإقرار بالأمر، فإن هذا الإغراء كان، حتى اليوم، داعيا لتسليم المحيط بدولة لبنانية هذا طرازها. وهو داع من بين دواع عدة معلومة. ومن نافلة القول أن اللبنانيين قدّموا – مرعيّين بصيغتهم الموصوفة بال"فذّة" – طليعة للضحايا في حالي التقاتل الداخلي والتنازع الإقليمي-الدولي كليهما.
المحشر
فما الذي يحصل كلما عمد أحدنا إلى تسليط نور الشمس على ظلمة هذا المحشر العويص بين استبعاد الاستبداد واستدراج الحرب الأهلية؟ والحرب الأهلية لا "تسبقها"، بالضرورة، "الصلاة على النبي" (فهذه " تسبق" تلاوة الفاتحة جماعة، ويجهر بها أيضا ردّا لعين الحاسد عن صنعة الخلاق العظيم أو تصبّرا على المكروه)، وإنما "يسبق" الحرب الأهلية عندنا انحلال السلطة العامة مقرونا بالفساد الهيكلي المعمم وتوزع المجتمع قطائع عصبية. فما الذي يحصل إذن حين ينبّه أحدنا إلى هذا؟ يحصل أن المحامين عن الصيغة يسمعون المجترئ على تعكير الغطيط المعمّم كلاما من محفوظاتهم، من بين درره أن "الديمقراطية لا تكون كاملة أبدا" وأن "المجتمعات التعددية موعودة بالقلاقل دائما"، فكيف بها إذا اتفق وجودها في إقليم شديد الاضطراب؟ ثم يصرفونك راشدا ويأوون إلى أفرشتهم مرة أخرى. ما نراه نحن هو أن الكلام الذي يستهين إلى هذه الدرجة بمحنة الحرب اللبنانية ويأبى أن يستفيد منها عبرة غير أن ننتظر أخريات من قبيلها ونحن مكتوفو العقل واليدين، لا يستحق إلا أن يستهان به. اجتازت سويسرا، من بعد سقوط نابليون، حروب أوروبا المتعاقبة وبينها حربان عالميتان، وبقيت تجمع السلم الداخلي إلى التعددية، تكللهما ديمقراطية لا تزال تجد متسعا لاستفتاء المواطنين في أساليب صناعة الأجبان. فإذا كانت سويسرا هي المريخ، في عين طموحنا (ونحن، مع ذلك، "سويسرا الشرق") فإن تركيا حفظت رأسها أيضا، عبر حربين عالميتين ذهبت أولاهما ب"ممالك" آل عثمان، وهذا مع ما في تركيا من أحناف وأكراد وعلويين ونصارى ويهود وخلافهم.. جلّلتهم إلى الآن علمانية الدولة وديمقراطية غير كاملة (والكمال لله) وسلم أهلي أمسى رجراجا، في العهد الأخير، ولكن اللبنانيين – بعد ما حلّ بهم – ما كانوا إلا ليجدوا كفايتهم في مثله. فإذا صح أن تركيا تعدّ دولة كبيرة، فإن الأردن يدخل ولبنان في فئة من الدول واحدة. وهو قد أفلح في درء الحرب الأهلية عن بنيه، أي عن شعب نصفه من عشائر البادية أصلا ونصفه الآخر من فلسطينيين عينهم على فلسطين، وكانت دولتهم تقاتل منظمات الثورة الفلسطينية لا غيرها. حصل ذلك والأردن يتوسط إقليما يحده جبروت إسرائيل وعين سوريا المحمرّة على الدوام و ديماغوجية مصر الناصرية وازدواج السياسة السعودية ونزوع البعث العراقي إلى بسط هيبة "المهيبين" من حكامه على من في الجوار. فما الذي عانيناه نحن من ضغوط تفوق هذه الضغوط؟ في كل حال، ليس لبنان سويسرا ولا تركيا ولا الأردن. ولم يكون عليه أن يكون دولة أخرى لينكب على المعضلة المتصلة من ماضيه إلى مستقبله؟
في الاستيراد والتصدير
هذا وينفع ما سبق من أمر لبنان في تدبّر مسألة أخرى أوفر عمومية، وقد منحتها الحالتان الأفغانية والعراقية راهنية جديدة، وهي مسألة تصدير الديمقراطية. نلمّ بهذه المسألة من جهة الصلة بينها وبين مسألة الديمقراطية والسلم الأهلي وما يتبعه وهي مناط كلامنا ههنا. وإذا كان للديمقراطية أن تصدّر فهي تصدّر لا بما هي ثقافة وطراز اجتماع – فهذا يطول انتظار المستورد لوصوله – بل بما هي نظام للحكم وقوانين. تصدّر هذه إلى بلاد يأبى المصدّرون العالميون أن ينظروا إلى خصائص البنى الأساسية لمجتمعاتها. والحال أن خصائص التشكيلات الأولية المكونة للمجتمع وكيفية معالجة العلاقات بينها وبين التشكيلات الثانوية التي تفترضها الديمقراطية وكيفية إنشاء هذه الأخيرة حيث لا توجد أصلا وكيفية توطيدها إنما هي المسألة الأولى التي تطرح على مجتمعات يطلب إليها أن تصبح ديمقراطية. هذه مسألة تتجاوز إلحاحا مسألة الإنماء وصلته بالديمقراطية. وهذا مع أهمية الإنماء، طبعا، بما هو سبيل – لا هو وحيد ولا هو مضمون – إلى تكوين قاعدة للديمقراطية. وما لا يصح تناسيه أن الديمقراطية تصدّر اليوم في ركاب الليبرالية الجديدة. وإذ تطيح هذه دولة الرعاية في أقطار لم تتوفر على "مجتمع مدني" منظم وموفور الموارد يحمل ما يخلّفه من أعباء انسحاب الدولة من الساحة الاجتماعية، يجد الضعفاء ( وبعض الأقوياء) أنفسهم كالمرميّ في اليمّ مكتوفا. فالحال أن تكوين الدولة في هذه الأقطار، لجهة بعده عن صفة دولة القانون، يعيل كثيرا من الناس ويوفر لهم نوعا من الأمان المكفول بالقانون حينا وبتراخي القانون وسهولة خرقه حينا آخر. فتفيد جمهر ة من الناس، في لبنان مثلا، من الضمانات الا جتماعية العادية وتفيد أيضا من التضخم في أجهزة الدولة والأمان شبه المطلق في الوظيفة والإعالة المموهة بدعم الإنتاج وتعويض الأضرار. ويفيد بعض هذه الجمهرة أيضا أو يفيد غيرها من الرشاوى أو الخوّات يقايضون بها نفوذا سياسيا أو إداريا تتفاوت درجاته وتتراكب. ويفيد آخرون من مزاولة المهن غير الشرعية أو من تخطي الشروط القانونية لمزاولة مهن أو أعمال أخرى.
هذا ويتصدر قطاع الجمعيات في بلادنا – مثلا أيضا – سرب كثيف من جمعيات محمولة على عاتق المجتمع التقليدي، فيها العائلي وفيها القروي وفيها الطائفي. وهذه تستمد حيويتها من استنفار المهاجر استنفارا غير بريء من الطائفية أبدا، ومن دعم دول قريبة وبعيدة يحركها المعيار الطائفي غالبا أيضا ومن مقايضة النافذين في الدولة اللبنانية دعما بدعم وهذا كله متصل ومتداخل. وهذا كله تهدده الليبرالية الجديدة ودولة القانون لأنه غير مستغن عن الحماية السياسية وعن صرف النفوذ. فحتى المغترب المتبرع لمدرسة خيرية يستحسن أن يكون أولياؤها نافذين ليبادلوه منّة بمنّة أو ليرتفع بارتفاع مقامهم شأن الطائفة السياسي في البلاد ويشتد أزر مؤسساتها. وأما الجمعيات العلمانية فعلا وما جرى مجراها من مؤسسات فلا تفلح في مجاراة شبيهاتها التقليدية عدة ولا عددا وتلفي نفسها، إلى هذا الحد أو ذاك، رهينة التمويل الأجنبي أو الدولي، وهذا حين لا تكون أجنبية التابعية صراحة. فهل أعدّت الليبرالية الجديدة، وهي تلبس لبوس دولة القانون و تنبذ دولة الرعاية، عدّة ما لمعالجة هذه الحال، بما فيها من بؤس يبرز في لبوس الأمان.. عدّة تعتدّ بها لحفظ السلام الأهلي وما يتعلق به حيث تحط رحالها؟ أم أنها ستكتفي بالنظر الشزر إلى المرتشين العاطلين عن العمل والمرضى المطرودين من جنة الضمان الصحي والتلامذة المقذوفين إلى خارج المدارس وإلى الأسر المحرومة الإفادة من ماء الدولة وكهربائها بلا مقابل وإلى مزارعي التبغ وقد حجب عنهم دعم الدولة المالي؟ هل ستسرّح الليبرالية الجديدة نظرها الشزر في هذا الجراد المنتشر ثم تأمر دولة القانون الجديدة بإلقاء القبض على كل إرهابي فيه متنكر في إهاب جرادة؟ هل ستترك المتطفلين على المجتمع من مواقع الدولة وعلى الدولة من مواقع المجتمع يتطفلون على المجتمع من مواقع المجتمع (وهذه هي سنّة المافيات) ليعودوا من هناك إلى محاصرة الدولة؟ أم هي ستترك حقا في النظر إلى دواعي السلام الأهلي ومهلة لتدبرها لمن تأمرهم بالبصم على صادراتها من صنف القوانين الجاهزة؟
ليس معنى كلامنا هذا أن الديمقراطية يسعها أن تنشأ من غير قوانين ولا مؤسسات ولا أن كفالة الحريات بالقانون والحد من الاستبداد بقوة التشريع شأن تصح الاستهانة به. ما نقوله هو أن استتباب ديمقراطية فعلية تحفظ السلم الأهلي وما يليه أو يتصل به (بما في ذلك الديمقراطية نفسها) إنما هو شأن آخر لا تستنفده أحكام القانون ولا يصدّر أو يستورد وإن كانت تسعفه كثيرا، في المدى الزمني الملائم، صلات ملائمة بالمحيط وبالعالم. استورد لنا الفرنسيون، سنة 1926، دستورا لا يسع المتأمل المنصف إلا أن يحيي إعراقه في الديمقراطية. استوردوه لنا من فرنسا ومن بلجيكا ومن مصر. وما سبق عرضه بيان لما فعلناه بهذا الدستور في 77 سنة. فكان – لعوامل نحمل جلّ تبعتها – أننا لم نحصل على كثير من الديمقراطية ولا على كثير من السلام. وكان – وهذا هو الأهم اليوم – أننا لم نضمن مزيدا من السلام ومن الديمقراطية للغد.
*****
ليس لي بلاد غير هذه البلاد ولا أحفظ ولاء لغيرها. وإذ أجد نفسي أقلّ ولاء بكثير لما يسمى الصيغة اللبنانية من الرئيس محمد خاتمي، فإن هذا يملأ نفسي غمّا. على أن الغمّ لا يحملني على الاعتذار.
بيروت في أول حزيران 2003
كلمة ألقيت في مؤتمر الديمقراطية والسلام الذي نظمته لجنة الأونيسكو الدولية للديمقراطية والتنمية وشعبة الفلسفة والعلوم الإنسانية في الأونيسكو (باريس) والمركز الدولي لعلوم الإنسان (جبيل)، وذلك في بيروت يومي الثاني والثالث من حزيران 2003