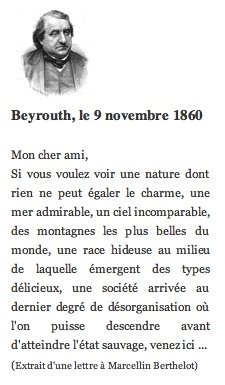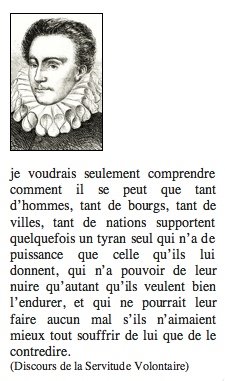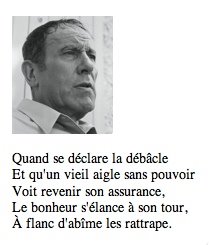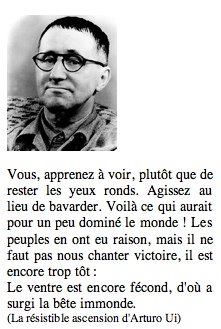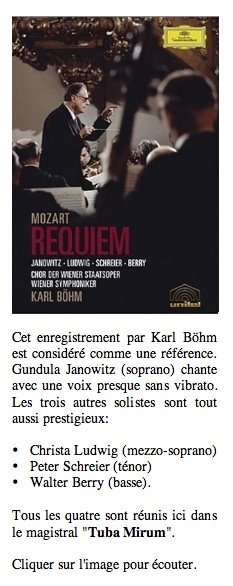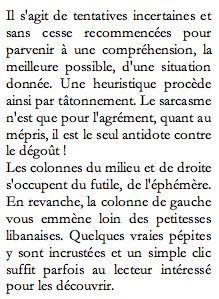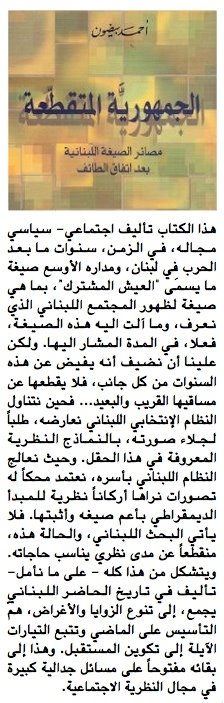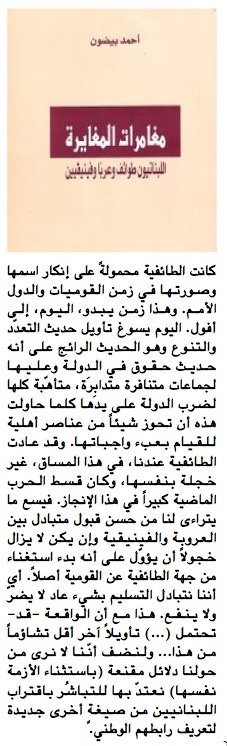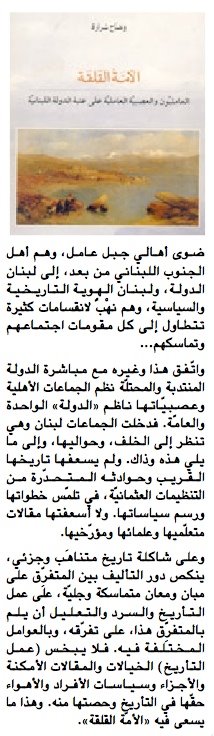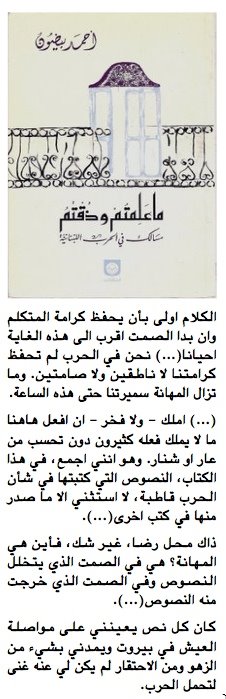Waddah Chrara fait le bilan du 14 mars, un an après.
١٤ آذار جمهوراً وساحةً ومصادِر وآداباً
وضاح شرارة
جاء جمعنا هذه المرة على غير عهدنا بجموعنا من قبل. فبعضنا جاء حين بعض آخر كان يروح. ولم يستقر معظمنا بموضع واحد. ولم ينضوِ تحت جناح جماعة أو فرقة. ولم ينشد دفء أهل. ولم يقصد موضعاً بعينه. ولم يهتف هتافاً أو شعاراً يجمع في جملة موقعة "سمات المرحلة الراهنة" و "مهمتها".
دخلتُ ساحة الحرية، وهي كانت ساحة الشهداء يومها، صباح 14 آذار (2005)، من بوابتها الغربية، بين مباني اللعازارية القديمة والمتجددة الى يميني والمسجد الأعظم والشاهق، المسجد الكاتدرائية بإزاء كاتدرائية مار جاورجيوس المتواضعة والمتضائلة، الى يساري. وفي زحمة الأعلام والرؤوس والوجوه والعيون التي دهمتني، عينين ورأساً وصدراً، وحاطتني من الجهات كلها، سماءً فوق الرأس وسماء داخل الوجه والرئتين والجسد، اقتصرت الساحة على نفسها وأهلها. وقامت بنفسها، دون الجبل أو الهضاب التي تحل بآخر سفوحها، وأقرب هذه السفوح الى ملتقى شرفات بيروت المفضي الى البحر. ولم يبق من إطار الساحة إلا زاوية قرية الصيفي المثقلة بالناس وألوانهم وهاماتهم، وإلا صفحة البحر التي ابتعدت فجأة واقترنت، منظراً، بالسماء. وفاضت الساحة وطافت طوفاناً رفيقاً بلوني العلم اللبناني البارزين، الأحمر، الأحمر خصوصاً، والأبيض الناصع. وسبحت الجموع، ومعها فضاء الساحة ومن بعده الفضاء الأوسع فالأوسع، في همهمة طافت بدورها الطوفان الملون والرفيق إياه. فخرجَت من بين الناس خروجَ عيون الماء، وانسابت جداول، واجتمعت بحراً دافئاً تتدافع أمواجه في بعض المواضع، وتزبد زبداً على حدة قبل أن تهدأ وتتبدد، ثم تنعقد في مواضع أخرى.
نداء الساحة الجامعة واستجابتان
ودخولي الساحة على هذا النحو بدا لي، من غير تأمل أو فحص، شبيهاً بدخول غيري. فما خرجت به الساحة، وجموعها وأعلامها وهمهمتها، عن مثال التظاهر الذي الفته وخبرته منذ عشرات السنين، هو إقبال المشاركين، وأتردد في تسميتهم المتظاهرين، على الجموع، ودخولهم الجمعَ وفيه، آحاداً وافراداً. وليس (معنى) ذلك أنني دخلت الجمع العريض، واشتركت فيه حاضراً وماشياً ومستمعاً ومتصفحاً ومراجعاً (مشتركين آخرين)، وحدي ومن تلقائي، وحسب. فأنا دخلته فعلاً على هذه الحال، ولم أوسِّط بين المجتمعين وبيني جماعةً وسيطة، أهلاً أو زملاء أو صحباً أو رفاقاً. وحسبت يومها، ولا أزال على حسباني، أن شأني هذا هو شأن غيري، معظمهم إن لم يكن كلهم. والغير اللجب هؤلاء أجمعوا، أو كادوا، على هذا من غير تواضع عليه أو تعاهد وتشاور. ولا ريب في أن شطراً كبيراً، وربما راجحاً، من الجمع العريض جاء من بعض الأحياء القريبة، ومن مدن وبلدات وقرى أبعد، جاء جماعات: أهلاً وجيراناً وأحلافاً وأحزاباً وغرضيات وعصبيات. ولكنني أزعم أن نداء الجمع، أو الداعي الى دخوله والإقبال عليه بهذا الموضع وفي هذا الوقت، توجه علينا أفراداً وآحاداً. فالمنادي، إذا جازت العبارة، أي مصدر النداء، وهو رفيق الحريري أو المعنى الذي انقلب اليه الرجل وحلّه غداة اغتياله، هذا المنادي كان عاماً. فلم يكن الزعيمَ السنّي، ولا السياسيَّ الذي تولى رئاسة الحكومة أعواماً مكفهرة، ولا الحليف والسند المتنازع، ولا كان رجل الأعمال البارز، إلخ. فنداء المنادي صدر عن معنى جامع وكثير الأوجه، هو الباب الذي دخله الواحد منا الى نسْج نتف حياته واختباراته وأوقاته المشتركة في سياقة متصلة ومجزية. ودخل واحدنا الباب "الحريري" هذا قادماً من اختباراته الشخصية والمشتركة، من غير وصلة بينه وبين غيره. والأدق القول من غير وصلة سياسية، صاغها أصحابها على الوجه والمثال المعروف هذا. وعليه، دخل معظمنا الباب "الحريري"، إذاً، منقطعاً من الجمع الذي يشارك فيه، وييمم صوبه، ولن يلبث أن ينضوي تحت اجتماعه ووحدته. لكن التقطع لا يبدد النتفَ والشذرات هذه ولا يذروها التكرارُ الرتيب رتابة السلطان وجلموده، هباءً وعبثاً. ولا تحول "السياسة" الصماء، المنقطعة من الجماعات، ومنازعاتها واحتياجاتها وأفرادها، بين الأوقات الكثيرة (وأهلها) وبين انعقادها على آفاق واحتمالات غير مسدودة. فكان النداء هذا إيذاناً بالخروج من الحجرة المقفلة، ودعوة الى الخروج من الأسر والقعود الى فضاء طليق.
وقد يكون عسيراً تفحص كيمياء المنادي (وندائه) السياسية والاجتماعية والمعنوية، وتعقب السياقات الكثيرة التي أدى انعقادها، غداة الاغتيال في 14 شباط، الى تلبية النداء، والاجتماع في الساحة الجامعة (على مثال "الصلاة جامعة"). (وبعضنا ابتدأ التفحص والتعقب هذين، وليس هنا موضعهما). فما يريده الإلماح المتقدم الى نداء الرجل الذي انقلب، غداة مصرعه، الى عَلَم على سياقة متصلة وإهابة، هو تعليل الإقبال العريض على الساحة الجامعة على شاكلة تلبية دعوى الى عيد واحتفال فرِح. فالرائحون الى الساحة، المتقاطرون عليها وإليها تقاطر حبات المطر، جمعوا في تلبيتهم استجابتين: الأولى استجابت داعياً عاماً ومشتركا، أو جمعياً وطنياً، والأخرى داعياً خاصاً أو فردياً. وهذا الداعي نشأ في ثنايا خفية وعميقة من النفس، واتصل برغبات في الحرية والكرامة والعدالة والأمن والصدق لم تكبتها أعوام الترويض على الامتثال والسكوت والمبايعة والتوكيل والكذب، ووجدت في مصرع الرجل الذي قتل قبل شهر التمثيل عليها.
احتفاء وأنس وهشاشة
فجاءت التلبية العريضة على غير موعد صارم ودقيق، أشبه بالانتباه من نوم ثقيل، وبنفض النائم ثقل الخدر عن رأسه وجوارحه، وتحرره من قيوده ووثاقه وكمامته. فقصدنا الساحة على نحو قصد الناس أعراسهم وأعيادهم ومشيهم اليها، خفافاً (متخففين من القعود والخوف، لا شك، ومتخففين كذلك من أثقال روابطنا الجمعية وقيودنا العصبية وانضباطنا القسري بها وعليه)، ومستقبلين الآتي من أيامنا وزمننا، ومقبلين بعضنا على وجوه بعض من غير مشية إلا تلك التي تلامس انتظار المنتظر ولا تنفك منه. فالاحتفاء غلب عليه الأنس الى التحلق حول المعنى الذي حرره افتضاح التعسف وغاشيته، واستئنافنا واحداً واحداً رغباتنا في الحرية والكرامة والعدالة والأمن والصدق، من حيث تركناها وخلفناها وراء أظهرنا، وكدنا ننساها أو نسيناها فعلاً. ولا أنكر أن كثرتنا، وامتلاء العينين من هذه الكثرة ومن أعلامها (أي علمها الواحد والمشترك)، أثلجت صدري، وبددت معظم الخشية من الشيل في الميزان السياسي. ولكن الكثرة هذه كانت خسرت "روحها" ومعناها لو لم تقترن بدواعيها وبصور تلبيتها. ومثَّل على هذه الخسارة، على زعمنا، مواطنونا الكثر الذين اجتمعوا قبلنا عشرات الآلاف ومئاتها على مقربة من "ساحتنا" قبل نحو أسبوع من اجتماعنا. فكانوا كثرة من غير "روح"، آلية أو ميكانيكية معتادة، أو كثرة من غير هذه الروح التي استفقنا، من غير تمهيد ظاهر، على ولادتها فينا، أو على "انبجاسها" (على قول أرسوزي متأله ووثني، مقلق الفظاظة والمزاعم "الانبعاثية").
ففرحنا باستعادتنا رغباتنا الهامدة، وبفك أسرها الجمعي والعصبي والفردي. ولم يفارق فرحنا، الى اليوم، توجُسنا من ضعفنا ورقتنا (على الضد من الشدة والصلابة) وهشاشتنا. فاجتماعنا وكثرتنا لم يصدرا عن موجب ولا عن فرض. ولم ننفك، في مسيرنا الى الساحة الجامعة وفي أثناء اجتماعنا، من الترجح والتردد وتقديم رِجْل وتأخير أخرى. فجاء جمعنا هذه المرة على غير عهدنا بجموعنا من قبل. فبعضنا جاء حين بعض آخر كان يروح. ولم يستقر معظمنا بموضع واحد. ولم ينضوِ تحت جناح جماعة أو فرقة. ولم ينشد دفء أهل. ولم يقصد موضعاً بعينه. ولم يهتف هتافاً أو شعاراً يجمع في جملة موقعة "سمات المرحلة الراهنة" و "مهمتها".
فهذه كلها هي جزية مجيئنا آحاداً وأفراداً، من وجه، وفريضة قصدنا عامّاً وطنياً جامعاً ومرسلاً، من وجه آخر. ومن جاء على هذه الشاكلة يسعه، أن يُبطل مجيئه (على مثال أبطال وضوء أو صلاة)، ويرجع فيه، وينفضّ عن الجمع، ولا تمتنع عليه هذه (الأبطال والرجوع والانفضاض) كلها. ومن جاء على هذه الشاكلة لم يلزم نفسه مترتبات نظن ترتبها على مجيئه. فلم يلزم نفسه العودة الى التظاهر وتلبية الدعوة اليه، ولا ألزمها التعلق بأحد "أعلام" الجمع، ولا الإقامة على تعلقه إذا ارتضى علاقة وآصرة، ولا الاقتراع لمن مال إليهم من الجماعات المجتمعة. فبين الجمع المؤتلف من الآحاد والأفراد، والميمم شطر العام الوطني والجامع، وبين الأجسام أو الكيانات السياسية والاجتماعية المستقرة على هذا القدر أو ذاك، فجوة أو هوة واسعة أو ضيقة. وسد الهوة هذه منوط بنظام اجتماع سياسي متماسك وقوي المباني. وهو ثمرة تاريخ طويل، إذا قيض تاريخ كهذا لأهل الاجتماع وأرادوه ورغبوا فيه، وحصلوا عدته.
وجراء هذه الحال، أقام الجمع العريض واللجب على سكينة وإمساك ليست علتهما في مرجع مركزي تولى التنظيم، وكان القوّام عليه. فهذه كلها، المرجع والمركز والتنظيم والقوامية، لم تكن. وما كان منها اقتصر على نواحٍ قليلة، وأوقات متقطعة. فلم تعصف في جمع الساحة الجامعة حمى الكثرة العصبية، ولا استخفته نشوتها أو "غنائيتها". وبعض الجماعات أو الفِرق التي ظهرت عليها أعراض الحمى متأخرة، أو على وجه الاسترجاع، فنسبت الى نفسها "أصل" الجمع ووقفت "الأصل" المزعوم عليها، وعظمت "حصتها" من الجمع، لم يكن في وسعها إعلان دعاويها في أثناء الاجتماع. فهي فاجأها الأمر شأنها شأن غيرها. ودخلت، فِرقاً وأفراداً، تحت "القانون" الذي سرى على المشتركين، وبعثهم على الاشتراك أفراداً وجسماً وطنياً معاً، من غير توسط (عصبي) بين الاثنين.
مصادر أهلية وأخرى فردية ووطنية
ولست أشك في أن ما تقدم قوله لا يخلو من المبالغة والغلو في التصوير، وفي استيلاد المعاني والدلالات وحملها على الصور حملاً متفقاً ومطابقاً. ولعل هذا من بنات الحماسة والرغبة في سند قوي يسند مزاعم مستقبلية (لا علاقة لها بـ"التيار") وسياسية، وتحتاج تالياً الى بعض المُسكة والقوة والدوام، وإن اقتصرت على استعمال أو تدبير فردي. ولكنها مبالغة لا تعدو، من وجه آخر، توسيع أو تعظيم وقائع حقيقية. وهذه الوقائع مشهودة ومعروفة. ومجرد رصفها من غير نظام ولا ترتيب، على قدر المستطاع، يسوق الى المعاني التي سبق تعرفها.
فمعظم الجمهور كان فتياً وشاباً. وكانت حصة الفتيات والنساء فيه كبيرة. وقدم معظم الناس إما أفراداً وآحاداً، وإما أسراً قليلة، وإما أصحاباً وشللاً. والكتل الحزبية نفسها، ما عدا ربما بعض القواتيين الشماليين وبعض أنصار الحريري من الشمال والجنوب، الكتل هذه لم تكن مرصوصة. وتفرقت جماعات (زرافات، على قول مدرسي) قليلة طواها الجمهور العريض في ثناياه وبددها، فلم تفلح في صبغ ولو ركن أو زاوية من أركان الساحة الجامعة وزواياها بصبغتها. وقلما قوي هتاف، أو شعار، أو ردة، على التمكن في موضع. فكان على القواتيين الشماليين أن ينتحوا ناحية من الساحة، طرفية، ليبسطوا عليها نفوذهم، ويرفعوا أعلامهم، ويرددوا رداتهم وأهازيجهم. وصنيعهم هذا كان بمنزلة الاعتزال والانتحاء، والخروج من الساحة وجمعها، وعليهما بعض الشيء. وهذا، وغيره مثله، قرينة على ان الجمهور صدر، على هذا القدر أو ذاك، عن مصادر أهلية وعصبية كثيرة. ففي الأسبوع الذي سبق 14 آذار انصرف الأعيان والقادة، و "أجهزتهم"، الى تعبئة الأنصار، وحشدوا أساطيل الحافلات والباصات والسيارات. وعينوا مواضع اللقاء والانطلاق. ولكن هذا لم يحل بين الجمهور وبين التفرق والتنقل.
ولعل السبب في استحالة ثبات كتلة من الكتل على تكتلها هو "سيولة" الجمع الداخلية، أو ظعن أفراده وزرافاته ورهوطه داخل الساحة والجمع. فهم قدموا على هذه الشاكلة (أفراداً وزرافات...)، ودخلوا الجمع عليها. فلم يشدهم موضع بعينه. ولم يضوهم علم. ولم يجمعهم شعار (وهو ثوب أو لباس، وصرخة حرب). فتفرقوا في جمع غير حربي، وفي ساحة ليست حمى "قوم"، ولا مضرباً، ولا ربعاً، ولا أهلاً. فوسع من شاء الرد على قول يسري في حلقة من الحلقات، والتمني على القائلين ترك قولتهم. ومن ثبت على محل وموضع، و"أقام" فيه بين صحب ورفاق وشلة وجيران، لم يرفع علمه، ولا بسط لافتته، ولا حمل على الأكتاف والرقاب صاحب هتافه وأرجوزته، ولا سار في صف، ولا وقف في مربع وإطار. وجاز لمن شاء أن يجلس ويقتعد الأرض، وأن يقرفص، ويروح ويجيء. ولم يمتنع الجمهور من المحادثة أو بين الثلاثة والأربعة والعشرة. وقلما تركت حلقات الجمهور الضيقة أو الواسعة دائرتها الى دائرة أعرض. فالدوائر كلها أو معظمها محلية وجزئية.
شعب لبناني متدافع وملتبس
ولم تقو الخطب "المركزية" على تحليق الجمهور حلقة واحدة حولها، أو حول خطبائها. ومن أصاخ بأذن الى خطيب، أدار الأخرى الى مصادر قول قريبة، وبادل القائل أو القائلين الكلام والرأي. فلم ينقطع الكلام في أي وقت من الأوقات. ولم يأخذ خطيب على المشاركين "مجامع قلوبهم". فالجامع المشترك، بهذه الحال، على خلاف جامع الجماعات العصبية أو الحزبية و"التيارية" (على اختلافها)، لا يتمثل عيناً ولا شخصاً ولا كلاماً، قدسياً أو مقدساً، على زعم ثابت، أُعلن أم أضمر. فهو لحمة الجمهور العصية على التمثيل والتجسيد. والجمهور العريض نفسه لا يستوفي التمثيل على اللحمة، شأن "فكرة" الشعب في الديموقراطية (وربما على خلاف فكرة الأمة، على معناها الزمني والعلماني). وعلى هذا، ضمت الساحة الجامعة الشعب اللبناني على نحون متدافع أو ملتبس: فالشعب لا يضم، ولا يجتمع، ولا يحضر كاملاً. وهذا هو السبب في استحالة "حلوله" في حزب أو قائد أو جهاز، وفي بطلان دعوى الحلول وزعم التمثيل "الى الأبد" (ولو اقتصر الأبد هذا على أيام معدودة). وإذا جاز ضمه وجمعه وحضوره الكامل انقلب عصباً وجمهرة، أو قبيلاً "عظيماً"، أو "رهطاً ذهبياً" (تتاراً أو مغولاً) وغابة كثيفة (جرمانية أو "توتونية" ألمانية) وجحافل...
وهذا (الانقلاب) يتربص بالشعب، ويراوده عن نفسه، ويسعى في فتنته وحرفه عن رشده. ورشده هو قبوله اضطراب صورته، ورضاه، على مضض، انقساماته ومنازعات أقسامه وأجزائه وجماعاته وطبقاته. ورشده هو كذلك امتناعه عن الافتتان بصورته المجتمعة والواحدة، ومن الاستغراق في "عظمته" المتوهمة. فالرشد، على هذا، هو خلاف الشعبوية، ونقيض النازع الى إيجاب "الشعب العظيم" وإثباته واحداً ومجتمِعاً ومقاوماً ومؤمناً بوجه الأعداء الشياطين والأبالسة (و "الإمبريالية" و"القردة" أو أبنائها)، واطراح المدخولين والعملاء واليهود والمستكبرين وحيتان المال منه، ونفيهم أو سحقهم ورذلهم.
تنازع الإرث
ولعل بعض هذا راود "أهل" 14 آذار (2005)، ولا ينفك يراودهم ويغريهم، ويزين لهم الاستغراق في صورة الكثرة العظيمة والمرصوصة، وفي الشعب الماثل والمجتمع والناجز. والطعن في الانقياد الى الصورة هذه لا يخلص (أخلص) منه الى زعم تمثيل على الشعب اللبناني أصدق من تمثيل من يزعمون وراثة هذا اليوم، والولاية على إرثه وتركته (وكأنهما ثابتان ومعروفان). وهو راود، ويراود من يحسبون أن "14 آذار"، اليوم المشهود ومعناه، "سرق" منهم خلسة، وعلى غفلة من أهله وشعبه. فيستولدون اليومَ هذا (أي منه) جماعة لبنانية صرفة، لا انقسام فيها، ولدها "رفيق الحريري" (المعنى) وحلفاؤه، وولدتها سياسات متماسكة لم يتطرق إليها تردد ولا التواء، وخرجت تامة الخلقة وعلى رأسها خوذة، من فخذ جوبيتر (أو من ضلع آدم). ويترتب على هذا الزعم إغفال حوادث لا تحصى، ليس أقلها إرساء السلاطة (على مثال سلاطة اللسان، من التسلط والوقاحة) السورية على طاقم سياسي وقاعدة اجتماعية قويين ومتينين، وتمويلهما وتسويغهما.
ويستولد من يقولون بالسرقة والاختلاس،ويجعلون أنفسهم "الأصل" الذي تحدر منه فيض الجمهور المجتمع في الساحة الجامعة، يستولدون اليومَ نفسه "الشعبَ العظيم: الذي سواه بطلهم قبل خمسة عشرة عاماً، وبدده موقتاً القصف السوري في 13 تشرين الأول (اكتوبر) 1990. فحفظه من غير انقطاع، على الخلقة نفسها، تظاهُر المتظاهرين، واعتقال المعتقلين، واستجواب المستجوبين، وعذاب المعذبين، واعتصام المعتصمين، وخطب الخطباء، من الأنصار والمريدين والأصدقاء. فلما حان اليوم أو الحين (على قول القصص الشعبي) بُعث "الشعب" نفسه، واجتمع.وتغفل الرواية هذه وقائع لا تحصى. وليس أقلها أن معظم جمهور الساحة واليوم لم يشترك في "الملحمة" السابقة، العونية، إذا جاز حملها على هذه النسبة. وليس اضعف الوقائع المغفلة معنى وثقلاً صدور الشطر المسلم، السنّي خصوصاً، من الجمهور (وهو الجمهور الذي أطرح منه ميشال عون "مليون مسيحي" عشية 14 شباط/ فبراير 2006)، عن تاريخ (لبناني) خاص، أو عن وجه خاص من التاريخ المشترك هذا. فالتعسف والاعتباط والمصادرة والإكراه والتزوير والفساد والمراوغة والكذب والإذلال اجتمعت كلها، على ما رأى الشطر المسلم السنّي (ومعظم اللبنانيين)، في اغتيال رفيق الحريري. ومهد لها تمهيداً طويلاً وثقيلاً سوس اللبنانيين على النحو الذي ساسهم عليه حكام سورية طوال ثلاثة عقود.
فما اختبره بعض اللبنانيين، من أنصار ميشال عون ومريديه ومن غيرهم، "قواتيين" واستقلاليين معتدلين، في أنفسهم وأجسادهم، طوال عقد ونصف عقد من السنين، لم يشاطرهم إياه (لتعسنا كلنا) الشطر الأعظم من اللبنانيين، ولم يحملوه على المعنى الذي أراده الجهاز السوري "العامل" في لبنان واللبنانيين، وهو (أي المعنى المراد) تقويض وطنية لبنانية جامعة وقائمة برأسها. ولولا ابتعاد رفيق الحريري من الجهاز هذا وسياسته، وجهره ابتعاده، وإعداده العدة لانعطاف آتٍ يطوي الجهاز وسياسته، فكان الاغتيال جزاءه على اقتعاده وإعداده، لولا هذا لما خلص شطر من اللبنانيين عموماً والمسلمين السنّة خصوصاً، الى ما خلصوا اليه منذ 14 شباط 2005 وغداته. والحق ان تعويل أصحاب "المقاومة اللبنانية" وهم جلهم من المسيحيين على اختلاف وتفرق وتنازع على توحيد اللبنانيين على وطنية جامعة، وذلك في سياقة مقاومة التسلط السوري وسعيه في اجتثاث موارد هوية شعبية ودستورية (غير عصبية ولا جوهرية تجسيدية)، هذا التعويل مفرط في التفاؤل والجهل، من وجه أول، ومفرط في الاعتداد بالنفس والإرادوية، من وجه آخر.
الانتقال ربما
فالطريق التي أفضت الى 28 29 نيسان (ابريل) 2005، وأجلت القوات السورية عن الأراضي اللبنانية، طريق متعرجة، وكثيرة المحطات، ومتشابكة المراحل. ونسبة هذه الطريق الى "قانون محاسبة سورية"، ثم الى قرار مجلس الأمن 1559، وتوليد القانون والقرار من التظاهرات والاعتصامات والاعتقالات والاتصالات في المهاجر والوطن، مبالغة في التقدير والاحتساب والاعتداد. والمبالغة لا تبطل ثقل القانون والقرار ولا دورهما. وهي لا تؤدي الى القول بضآلة أثر التظاهر والاعتصام وديبلوماسية التأليب ("اللوبي"). ولكن ما كان ينقص الحركة الاستقلالية والسيادية اللبنانية على الدوام، ويطعن، فعلاً وحقيقة، في وطنية جسمِها الاجتماعي والأهلي (وليس في وطنية قصدها ودعواها)، هو إحجام "المسلمين" (سياسياً، أي الإسلام السياسي) عن تزكيتها، وانخراطهم، على هذه الصفة، في هوية وطنية مشتركة وغير مشروطة.
فالإسلام الأهلي والسياسي اللبناني نزع على الدوام الى توحيد السياسي بالأهلي (القرابي العائلي، وذاكرة الحوادث والحروب والهزائم والجروح القومية، والجوار). فأخَّر الهيئات والمؤسسات والمباني السياسية الدستورية، والادارية، والقانونية، والاجرائية، عن اللحمة الأهلية القومية. وارتضى إبطال هذه (اللحمة) المؤسسات والمباني، وتعطيلها إياها. فكانت الحروب الملبننة، وقبلها بقاء السلم الوطني في دائرة سلم أهلي بارد، وبعدها بناء "الدولة" على رمال "مسرح احتياطي" وعروبة سياسية متقلبة ورجراجة (تصرف الحرب السورية الاسرائيلية عن المسرح السوري المتداعي الى مسرح "مقاومة" بالوكالة غير مقيدة بوقت ولا إقليم ولا مصالح) كانت هذه الحلقات آيات الإبطال والتعطيل هذين. وأخرج مسار رفيق الحريري، وروافده التي لا تحصى، وتتويجه غير الإرادي (طبعاً) بالاغتيال، شطراً راجحاً من الإسلام السياسي هذا، ومن عروبته السياسية ولحمته الأهلية. وكان الخروج من باب لبناني، هو باب المصالح الاجتماعية و"الثقافية" الراهنة، ومن باب إرساء بعض التمثيل السياسي على اعتبار هذه المصالح واحتسابها، والتوسل بأواليات سياسية ودستورية الى الاعتبار والاحتساب هذين. وهذا شأن "الطبقات الوسطى".
فدخل الشطر الراجح من الإسلام السياسي اللبناني بنية سياسية وطنية (كانت في طور الانتقال، ولا تزال)، لم يسبق له عهد بدخولها العريض والشعبي على هذا النحو. وكان 2004 2005 (وحادثتاه البارزتان، الاغتيال و"التشييع" في 14 آذار)، المرحلة الواسعة والظاهرة من التحول الكبير، قياساً علينا. و"عيد" 14 آذار 2005، وجمعه التشييع الى عمادة المولود الجديد أو غمسه بالماء (على قول بني تغلب الى عمر بن الخطاب)، قرينة على التحول من حال الى حال. ولكن المولود لا يولد ساعة ولادته ولا يومها، بديهة. وهو يستقبل، حين الولادة، عالماً سابقاً، عليه أن يتألف مسالكه وممالكه. وهذه بديهة أخرى. و"ثقافة" التألف مثاقفة، لعل جمهور اليوم المشهود قرينة عليها، وعلى مدنيتها (على معاني الكلمة الكثيرة). ونقيض المثاقفة المدنية هذه بداوة عصبية وسياسية ديدنها الاستيلاء الفظ، والحشد المرصوص، والهوية الجمعية، وفك السياسة من الاجتماع، وإزمان الذاكرة المرضي.
النهار 18-03-2006