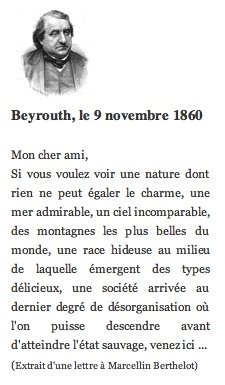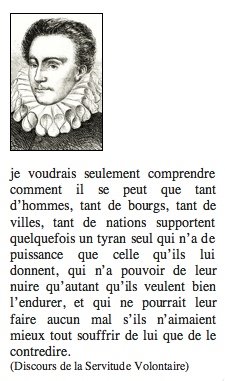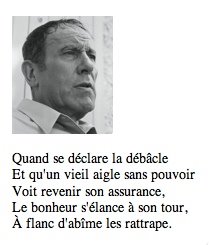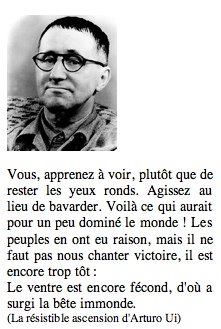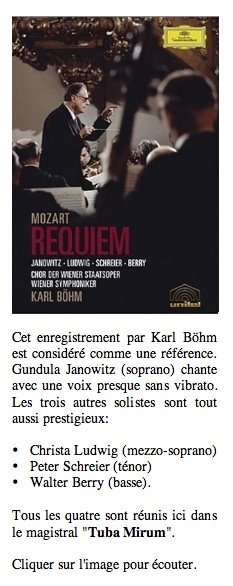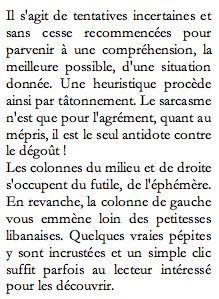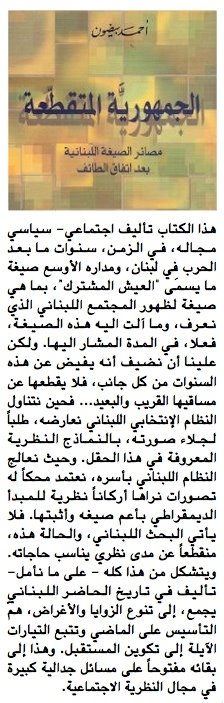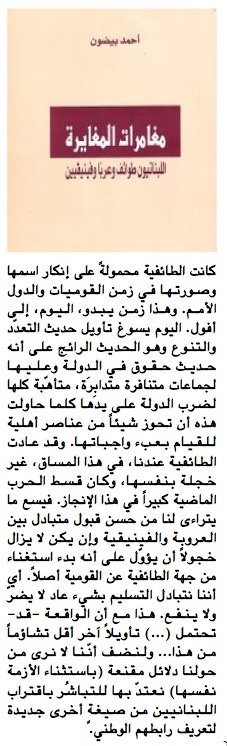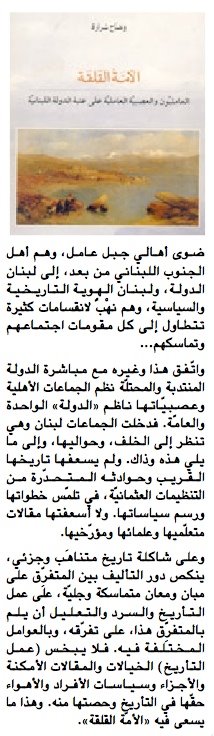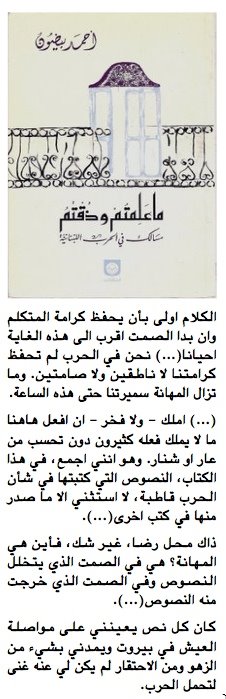Les mots de Ziad, chantés par Fayrouz
par Ahmad Beydoun
par Ahmad Beydoun
غناء فيروز لكلمات زياد
قمر الصباح الباكر يحكي بلايا آخر السهرة
أحمد بيضون
قمر الصباح الباكر يحكي بلايا آخر السهرة
أحمد بيضون
الصوت ولونه
كثيرا ما قيل إن صوت فيروز خلق للصباح. وتلزم محطات الإذاعة هذا الرأي لزوما إجماليا فتبثّ أغاني فيروز فيما الناس يرشفون فنجان قهوتهم الأول أو يمسحون فوضى الليل عن صور أجسامهم وعن دواخل بيوتهم مفتتحين بذلك منطق النهار. وقد لا تلزم محطات التلفزيون هذه القاعدة لأن التلفزيون آلة ليلية على التغليب. ولم يكن لفيروز نفسها أن تستغني عن السهر بشخصها مع الناس.. فالناس ألفوا، لأسباب لا تعتدّ بلون الصوت، أن يكون الغناء متاعا للسهرات. ولم يحصر الأخوان رحباني شعرهما المغنى بوقائع النهار أيضا. بل الراجح أن الليل كان أشدّ استدراجا لهما إلى الشعر لأن آية النهار مبصرة والشعر لا يوافقه كثيرا ما يفرضه النهار من مطابقة فظـّة (وإن تكن ظاهرية) بين صور الأشياء وأسمائها. عليه كانت فيروز، في عهد عاصي ومنصور، تغني، بصوتها الحي، في الليل... وهي قد غنت لليل كثيرا، في عهد عاصي ومنصور أيضا. ومع أن مانعا لا يمنع أن يأنس المبكرون للسماع إلى أصناف شتى من الأخيلة الليلية، فإن بين الأغاني التي كتبها عاصي ومنصور (أو كتبها غيرهما) لفيروز ما لا يصلح أصلا لمزاج السابعة صباحا: "بكوخنا يا ابني"، مثلا، أو "تخمين راحت حلوة الحلوين".
مع ذلك، لا نرى حدس محطات الإذاعة الإجمالي يجانب الصواب. وهو حدس يذهب المتأمل فيه، على الفور، إلى ضده المتعلق بأم كلثوم. فليس صعبا إقناع المنهك أو المتخم بأن شدو هذه السيدة بقول الخيـّام : "فما أطال النوم عمرا..." لا يوافق ساعة القيلولة.
يجد الناس للصوت أوصافا مختلفة، ويستعيرون لتسميتها من مصطلح حواسهم الخمس، وتسوقهم القريحة إلى استعارة مصطلح اللمس، خصوصا، لحاسة السمع. فيقولون: "صوت خشن" ويقولون: "صوت حاد". وأما أنا فأسأل: هل لصوت فيروز لون؟ ولا أسلـّم إلا مرغما، بأن فيروز سفيرتنا إلى النجوم. فإنما يغلبني الظن أن صوتها هو نور القمر. وليس يذهب خيالي إلى القمر الذي يطلع في أول الليل أو في وقت ما من أوقاته. وإنما أشير إلى القمر الذي يتأخر إلى ما بعد الفجر بساعة. ذاك هو القمر الذي سأنظر إليه لأتملى فيه من صوت فيروز ولن ألتفت إلى الشمس قط، وإن تكن طلعت. فليس يصحّ في هذا الصوت حديث الحرارة (أو الدفء) وما يخالفهما أي البرودة. هو صوت يلاعب الروح لا غير، فيجب علينا، كرمى لفيروز، أن نسلـّم بوجود الروح. والمعوّل عليه ههنا أنني لا أجد صوت هذه السيدة أصفر ولا برتقاليا. وأما النجوم فهي تلمع أكثر مما يجب بقليل.
تستعار المعادن أيضا لوصف الأصوات. ونهاية ما سبق أنني أجد صوت فيروز فضيا. وهو الفضة جليت من يومين أو ثلاثة لا من دقيقتين. وما هو بالذهب ولا بالماس ولا يزيده إلا عزّا ألا نعتدّ ، حين نصفه، بمقياس الأسعار. فنحن، حتى تاريخه، ننام ونقوم في بيوتنا لا في بورصة دبي.
العِـيّ
هل تركتنا فيروز مقيمين في بيوتنا فعلا طيلة نصف القرن الذي مرّ ونحن نسمع بصوتها ومعه شعر الأخوين رحباني وألحانهما؟ الجواب صعب لأننا كنا معها في أقصى الوحشة وأقصى الألفة، في آن. كنا في العراء ولكن هذا العراء كان هو المنزل الذي ولدنا فيه وبات، من يوم أن ولدنا، غير موجود. فليس غناء فيروز للأخوين رحباني غير هذا الاتحاد شبه التام للوحشة وللألفة. وأقول "شبه التام" لأن ما كان يقوله هذا الغناء هو، على وجه الدقة، أن بيت ولادتنا قد أصبح أطلالا ولكنه كان لا يزال قائما، بمعالمه كله فينا. كنا قد كففنا عن الإقامة فيه، مذ بات غير صالح لسكنانا، ولكنه كان لا يزال مقيما فينا.
الذي حصل حين ترك زياد حضن أمه ليعلـّمها كلاما لم يتعلمه منها أن البيت الذي كانت فيروز ترتبه فينا كل صباح تهدّم هو أيضا وأننا علمنا، في المناسبة نفسها، أن أطلال الخارج قد زالت هي أيضا أو هي أمست على مشارف الزوال. علمنا أيضا، أو وجب علينا أن نعلم، أن هذه سنّة الحياة وأنها سنّة الموت أيضا. فنحن في سن قريبة إلى سن فيروز أو إلى سنّ غنائها. وأما زياد وغناؤه فقريبان من سن أولادنا. أركن إلى هذا التعليل مؤقتا، عالما بأن الاحتجاج بالسنّ سرعان ما ينكشف ضعفه وأنه لا يعفي أحدا من المسؤولية عن ذوقه.
وقد كنت ذهبت، قبل عشرين سنة، في كلام وجيز على مسرح زياد الرحباني، إلى أن هذا المسرح يؤو ل إلى إخراج العِيّ اللبناني أي عجز اللبنانيين عن الكلام المفيد... أو قصور عبارتهم عن ملابسة المعنى المراد بها. هذا العيّ عيّ مداور. فاللبنانيون يقولون، في نهاية المطاف، ما يريدون قوله ويعرف بعضهم، في نهاية المطاف، ما يريد بعضهم الآخر أن يقول. حتى إن هذه المعرفة قد تسبق القول نفسه. ولكن المطاف المشار إليه يأتي طويلا معقـّدا ويشير، بطوله وبعقده، إلى مقاومة ما للقول السوي، للمختصر المفيد، وإلى عجز عنه. ليس ما يقال ضائعا إذن. ولكن في الاستراتيجيات المتقابلة للقول ما يجعله قولا بدلا من ضائع. وعلة ذلك أن بين اللبنانيين من الحوائل التي قد ينكرون والمكتومات التي يعلمون ما يجعل صراحة القول، في الدقيق والجليل من المسائل وبين الكثير أو القليل من المتخاطبين، بابا لقطع الكلام أصلا وللوصول فورا إلى أقصى التنازع. هذا بينما تقتضي الحال تجزئة التنازع، عبر التطويل في الكلام وليّ مجراه مرارا وتشعيبه هنا وهناك، بحيث يحول التنازع الكبير، القابل للفتح على مصاريعه كلها، إلى منازعات تفصيلية تطيقها حياة كل يوم.
هل بقي لعيّ اللبنانيين أو للحُبْسة في نطقهم هذا المثول نفسه في كلام الأغاني الذي كتبه زياد لفيروز؟ نعم و لا. في خانة نعم، أن زيادا لا ينتظر اجتهادنا في موضوع العي والحبسة وإنما يعلن حصولهما إعلانا مباشرا:
وهيدا جارو ما بيفهّم شي.
بيحكيلي خبريات
وبيحكي عموميات
وبيبرم ساعة عالكلمة وما بتطلع هي بالذات٠
وفي خانة لا، أن العجز عن الإفادة يتكشف عن إستراتيجية قائمة برأسها. تتمثل المرحلة الأولى من هذه الإستراتيجية في فرض النسيان على المحاور (أي ما هو عكس إفادته)
وبياخدني وبيرجّعني وبينسّيني
نسّاني والله نسيت٠
(...)
وهذا قبل أن تنتهي الإستراتيجية نفسها إلى فرض الانهيار على محاور أعيته الحيلة:
خبِّرني إنـّو جارو شو دبّارو
معقولي هالشي؟
بيحكي بين شفافو
وبيجاوب بكتافو
يعني الحكي مش متل الشوفي
فعلا لو حدا شافو...
بيتعّبني وبينكّدلي العيشي
وديني بكّاني، والله بكيت!
هي الحرب إذن، لا مدافع فيها ولا راجمات. فإنما يكفي منظر الخصم لتقع الهزيمة. ومنظر الخصم منظر واجهة لا تخرق. فهو أشبه بالحصن يحجبه ساتر هائل الصفاقة من مكعـّبات الإسمنت وأكياس الرمل. وأما الهزيمة فما هي غير خيبة الجهد لحمل الخصم على تقبل غاية مشتركة للكلام، أوّلا، ولحمله، ثانيا، على اعتماد مصطلح للكلام ومسالك وقواعد لتداول الكلام تفضي به إلى هذه الغاية لا إلى غيرها ولا إلى ضدها.
الفعل الناقص وفعل القول
ومن وجوه العيّ أيضا أن زيادا، إذ يحاول تعيين معالم بارزة لفقر الكلام اللبناني، لا يجد أمثل من الأفعال الناقصة، وخصوصا منها "كان" و"صار". وهي أفعال يسعها أن تكون تامة أيضا فلا يزداد مدلولها غنى أو تعيينا. ينشئ زياد أو يستعيد تراكيب تتكرر فيها هذه الأفعال وتطغى. ومن قبيل ذلك "مش كاين هيك تكون" وريتو عمرو ما يكون" و" ما بعرف شو صاير لك"... ويضاف إلى تكرار الأفعال الناقصة تكرار أفعال القول من قبيل "قال" و "حكى" و"خبّر". وهذه أفعال لا تقلّ نقصا عن سابقتها. هي متعدية تحتاج إلى مفعول. ولكن قد يكون المفعول الذي تحتاج إليه مفعولا لا كالمفاعيل. فأنت إذا قلت: "أكل حسن" كفاك أن تضيف التفاحة إلى الجملة ليتمّ المعنى وإن لم يشبع حسن. وأما إذا قلت: "قال حسن" فستجد نفسك، على الفور، تحت رحمة حسن الذي يمكن أن يحتاج إلى يومين ليقول ما عنده. لذا صحّ أن نعتبر أفعال القول، بحد ذاتها، بين أفقر أفعال اللغة مدلولا... فيتنوع مدلولها ويتشعّب، بحسب المفاعيل، إلى غير نهاية. وقد يكون مفعول فعل القول، عند زياد، ظاهرا ومحصورا: "اشتقتلك" أو" اشتقتلّي" مثلا. فيتكرر في جمل من قبيل: "اشتقتلّك، اشتقتلّي... بعرف مش رح بتقلّي"، و "طيب مش قصة ما تقلّي" و "طيّب أنا عم قلّك". وقد يبقى المفعول مقدّرا وعامّا، من قبيل "بتحكي وبتصير ما بتسمع". وفي الحالتين (وفي حالة الأفعال الناقصة أيضا)، نجدنا أمام نزاع أو خيبة أو غضب أو يأس ضمرت ملكة التعبير عنها إلى أدنى حدودها واقتصر زادها على المدقع من الألفاظ. ويتكرر فعل "فهم" أيضا مع أفعال القول ولكن ليعلن أن القول لا يصادف فهما وأن هذا الأمر إنما هو صورة النزاع والخيبة وما إليهما، أو هو أول ملامح الصورة، على الأقل.
تبقى الجمل مفتوحة، طبعا، أمام مخيلة السامع. فيسعه أن يودع في "مش كاين هيك تكون" أو في "ما بعرف شو صايرلك" حكايات وروايات. ويسعه أن يودع مثل ذلك في "بعرف مش رح بتقللي" وحتى في "قال عم بيقولو صار عندك ولاد". وذاك أن القراءة في الغيوم ممكنة لمن شاء. وأما فضل الغيوم في إمكانها فيبقى محل نقاش.
بين الحُبْسة والإفراط
أعود إلى العيّ والحبسة. هذان قد يتخذان أيضا، عند زياد، صورة الإفراط في دفق الألفاظ والإيقاع السريع لتتابعها. قد أذهب لبيان هذا الأمر إلى أغان ذكرتها دليلا على ضدّه: إلى "اشتقتلّك"، مثلا، أو إلى "مش كاين هيك تكون". ففي الأولى صف طويل من المواقف والعواطف: عمل الزمان وحصول النسيان، والغلط وعدم المواساة والإحساس بالعلّة و"العيشة عالهلّة" والاستفقاد... والشوق، طبعا. وفي الثانية ركام عجيب من الأشياء الحسية: الزيتون والصابون والليمون واليانسون والصالون والبلكون والكميون وسائر ما "يخلص بحرف النون". في الحالين، يجري عرض لحالة طارئة على عالم تسعى كلمات الأغنية إلى تفصيله. وهذا العالم، في الأغنية الأولى، عالم عواطف ومواقف، وهو، في الثانية، عالم أشياء حسية. في أغنية ثالثة (ذكرتها أيضا)، وهي "انشالله ما بو شي"، نقع على حشد غير ضئيل من البشر: على المشكو إليه وعلى الشاكية وصاحبها طبعا، وعلى "جارو" الآنف الذكر، ولكن أيضا، على "الدكنجي" وعلى "اللي بالأول" وعلى "أهل" الحبيب وأصحابه، أخيرا. في كل من هذه الحالات، إذن، تتبدّل المادّة التي أنشئ منها الديكور ويتغير معها الحقل الذي تستمد منه الألفاظ. يتخذ الشوق المضطرب الموقع موقعه في قاموس العواطف، ويجد ذواء الحب ديوانه في نصول ألوان العالم وضمور أبعاده وتعثـّر حركاته، وتعبـّر اللهفة عن نفسها في تصفـّح لإعراض البشر عن إغاثة الملهوف. وهذا كله حسن وإن كان يحسن بنا أن نعود إلى العلـّة المحتملة لملازمة الهزء والضحك هذا كله.
قبل ذلك، أحب أن أذهب، لاستقصاء الإفراط اللفظي، بما هو أسلوب مواجهة مرادف للعيّ عند اللبنانيين، إلى أغنية أخرى هي آية آيات الإفراط المذكور، وهي "لا والله". ههنا نقع على امرأة ذات ثروة عريضة من مفردات الكلام وتراكيبه وموهبة فذّّة في إطلاقه بسرعة وقوّة. وأما المدار الأول لكلا مها (وهو كلام احتجاج وتعنيف) فهو، على وجه الدقّة، أن حبيبها الذي تخاطبه يضارعها ثروة وموهبة في المضمار نفسه: مضمار الكلام. بل إنه لا يملك غير هذه الثروة إذ إن موضوع البيت وتأثيثه ما يزال معلقا. وخلاصة المبارزة (التي نسمع من طرفيها طرفا واحدا) أن "الحبيبة" تريد أن "تأكل رأس" الحبيب الذي يواظب بدوره على "أكل رأسها".
كلمة كلمة يا حبيبي تا إفهم عليك
أو فتـّش عن غيري يفهم إذا رح تبقى هيك
يكون بيحكي بسرعة قّدّك ما يسمع عليك
بتشارع ضيعة يا حبيبي وما بتقدر عليك
بدّك دولة أو شي أمة أو أكبر من هيك
يمكن كوكب أو شي أكبر تا يستوعب ليك!
ولأتجاوز هنا عن سطرين (سأعود إليهما من كلمات الأغنية) لأصل إلى ختام هذا المقطع الذي ننتقل بعده إلى قسم آخر من الأغنية يصبح فيه البيت والفلوس (لا الكلام نفسه) مدارا للكلام. ختام المقطع إذن:
بتحكي فوقي وبحكي فوقك شو رح نستفيد؟
صدّقني يوما عن يوم حكيك عم بيزيد
بتقللي بتضلـّي تعيدي وإنت العم تعيد
ومأكّد دايما من كل شي وما في شي أكيد!
هذه "الحرب الصغيرة" تكشح، أولا، كل أثر لصورة السعادة البطولية التي تفترض تربية تزعم لنفسها الشيوع عندنا أن اقتران الحب بالفقر يفتح أمام الزوجين المتحابين أبوابها (وهي نفسها أبواب الكفاح الصعب لـ"تحقيق الطموح" أو "للقناعة بالمقسوم"، على الأقل). لا أثر للقناعة ههنا ولا أمل يواكب الطموح. ولا تشنّ الحرب على خصم ما يعترض طريق الحبيبين، بل تدور الحرب بين زوجين نخمـّن أن عمر الحب في بيتهما كان قصيرا. وأهم ما يقوله الكلام الكثير من الجهتين أنه كلام لا طائل تحته ولا هو مفهوم أصلا ولا هو يغيّر شيئا من سوء الحال. يردّنا هذا، من باب آخر، إلى مسألة العيّ والحبسة. فهذا ن لا تعالجهما كثرة الكلام، بحد ذاتها. وسواء أكنّا أمام الذي "بيحكي بين شفافو وبيجاوب بكتافو" أم أمام الذي "بيشارع ضيعة"، بداية، لينتهي إلى مشارعة الكوكب أو ما أصبحنا نسميه، بعد ماك لوهان، "الضيعة الكوكبية"، فنحن أمام انسجام مفقود أو نزاع مفتوح، وبيننا وبين "التفاهم" (ولنسمّه "التوافق"، إن شئنا، ولنسمّه "الحوار") عرض السموات والأرض. ما الذي يجعل الحوار سرابا؟ إنها الحبكة المحكمة حبكها كل لنفسه وحبس فيها نفسه وحبس غريمه أو شريكه فيها أيضا. هذه الحبكة يمكن أن تكون حبكة الزوجة أو الزوج لما يراه (أو تراه) صورة لمستقبل البيت. ويمكن أيضا أن تكون رواية لتاريخ البلاد أو تصورا لمباني نظامها الاجتماعي السياسي ولخط سلوكها في مسائل المصير. في هذه الأحوال جميعا يستوي "الحكي بين الشفاف" و"المشارعة" التي يعلو فيها الصوت ويكثر الكلام ممسكا بتلابيب بعضه بعضا بحيث لا يتميز ولا يفهم. في الحالين، في البلاد وفي البيت، يكثر أن تبدو القدرة على الكلام مرادفة للعجز عنه أو لكتمانه.
ولكن "شو بدّي بالبلاد" على ما يقول زياد، بصوت فيروز، في أغنية أخرى. و"خلينا بالبيت"، على ما تأمر فيروز في أغنية كتب كلامها جوزف حرب. إذا صحّ أن الكلام القيّم لا يستغني عن نقض كلام سبقه ("الإسلام يجبّ ما قبله"، في رأي ذوي ملـّته) فأيّ كلام هو ذاك الذي تنقضه فيروز وهي تغني كلام زياد؟ مرّة أخرى، يوفـّر علينا زياد نفسه عناء البحث. "ما تبحثو... ما تبحثو"، تقول فيروز في "سلـّملي عليه!". أمرك سيدتي! لن نبحث!... في "لا والله" التي وقفت مع نصها طويلا، تشدو فيروز بمطلع أغنيتها القديمة: "ياريت! إنت وأنا بالبيت!" ثم تستدرك على الفور:
"بس كل واحد ببيت!
فعلا حلوي هالغنية بس جدّ انسمّيت!"
وهذه الإلماحات الهازئة إلى قديم فيروز تتكرر في ما تغنيه من كلمات زياد. من "كيف طلّ الورد بشبّاكي مع إنو ما دقّيت!"، في الأغنية نفسها، إلى " مش سامع غنّية راحوا؟" فإلى
"كاين راقي وحنون
أو مايل عالغصون"،
في أغنية "مش كاين هيك تكون!"، إلخ.
الرومانسية ووجه الآب
فمن يوم أن وضع زياد مسرحيته "شي فاشل"، وأخرجها وعرضها على خشبة مسرح جان دارك، في سنة 1983، لم يتعب من مناكدة أمه وأبيه وعمّه. وهو "يمون"، بطبيعة الحال. فموقعه لا يشبه في شيء موقع أي "إنسانة" "تمرق وتفرق وتصير تمون"! فإنما هو، مع فيروز والرحبانيين، في بيته، وهذا هو عالمه، وهو يعلم ذلك، لا ريب، وقد كرّس حياته، بما هو فنان، للخروج من هذا العالم وعليه، وهو حر في ذلك... بل إن هذا الخروج هو حريته عينها وليس لأحد أن يقترح عليه غيرها.
ومأخذ زياد على عالم الرحبانيين أن أصداء العالم الذي نروح فيه ونغدو ونتعايش ونتنازع، يفوته أهمها. فهو لا يصلح، بالتالي، مرجعا يردّ إلينا، بلغة أخرى خاصة، عالمنا الذي نحن فيه فيسعفنا في إدراكه حقا وقد يسعفنا في تغييره. ولكن ما هو عالم الأخوين رحباني؟ إنه، بالعبارة الوجيزة، عالم الرومانسية. توجد "أنا"، هي حينا لجماعة وأحيانا لفرد، تفرض نفسها بؤرة لهذا العالم وترتجل لها مخيلتها أو عزيمتها حقا في تسخيره وإلحاقه بها، بسائر مكوناته: من العشبة الطفيفة إلى المجرّة، ومن العناية الإلهية إلى العفاريت الصغيرة الداجنة، المقيمة في الجوار والمستعدة دائما للأخذ والعطاء... فإلى الشياطين الكبيرة القابلة، بثمن ما، للإقصاء إلى كهوفها البعيدة، ولو بعد حين.. عليه تملك الأنا أن تسترد توازنها كلما اختل. هي تستردّه حتى من الموت الذي هو شهادة، عند الرحبانيين، أي تركة باقية واستثمار مضمون، أو هو، على الأقل، مولـّد، بتوسط الألم وفي ما يتعدّاه، للرقّة البديعة وللاعتبار الثرّ في نفوس الأحياء. وقد كان طلال حيدر، لا عاصي ومنصور الرحباني، هو من أجرى، بصوت فيروز وتلحين زياد، كلام اللارجعة ووحشة الموت الذئبية والزمن الذي يعصي على الترتيب ولا يردّ منه طرف على طرف:
يا زمان!
ياعشب داشر فوق هالحيطان
(...)
يارايحين التلج!
ما عاد بدكن ترجعوا!
صوّت عليهن بالشتي، يا ديب!
بركي بيسمعوا!
الريف الداخلي
وإذا كانت الرومانسية آلة لإنتاج هذا العالم، فإن الريف اللبناني، بمعالمه المطبوعة والمصنوعة وبأهله، كان المسرح الأول (وبقي الأهم، وإن يكن توسّع لاحقا) لاستعراض العالم نفسه في فن الرحبانيين، أو لاستعراض صورة مركّبة له، بالأحرى. أقول: صورة مركّبة لأن هذا العالم لم يكن قائما على الصورة الرحبانية، في عهد من العهود، ولأنه كفّ عن الشبه بنفسه وضؤل حضوره في نفسه في زمن لم يدركه الرحبانيان، في كل حال. فقبل ربع قرن، تقريبا، من الوقت الذي ولد فيه الرحبانيان، كان الخوري يوسف تاتي يباشر جمع ما تيسر من تقاليد ريفنا الجبلي، منبـّها إلى أن هذه التقاليد، إن لم تجمع ضاعت لا محالة. وفي أواسط الخمسينات، أي حوالى الوقت الذي التقى فيه الرحبانيان نهاد حدّاد، نشر أنيس فريحة كتابا له تحت عنوان: "القرية اللبنانية: حضارة في طريق الزوال". وفي مطلع السبعينات، أي بعيد أن كانت "دبكة لبنان عالملقى"ّ قد هزّت معبد جوبيتير من أركانه، استأنف سلام الراسي مهمة إنقاذ التقاليد نفسها فنشر، وهو في سن متقدمة نسبيا، كتابه الأول: "لئلاّ تضيع". كانت هذه التقاليد ولم تزل، على الأرجح، لا تفرغ من ضياعها. وكان التقليد اختراعا للتقليد، على ما يشير إليه فواز طرابلسي مقتفيا أثر أريك هوبسبوم. فإن ريف التقاليد، بما في ذلك طبيعته، عالم داخلي بالدرجة الأولى. ولولا أن الطبيعة يسعها أن تكون عالما داخليا، لكانت أجلّ النجوم أتفه، في إدراك البشر، من مصابيح السيارات.
وعلى غرار القول: "فلك ما تحت القمر"، نقول إن ذلك العالم كان، بعجره وبجره، "عالم ما تحت السيطرة". ولقد أوضح فواز طرابلسي مجرى الأمور، في العالم الرحباني، بقريته ومدينته ودولته، إيضاحا ليس وراءه مزيد. يقع النزاع ولكن الصلح والنهضة التي تلي الوئام آتيان، لا محالة. يرزحون على صدورنا فنقدّم الشهداء ونزيحهم. ويكون العدل سلاحا للضعيف فينال من جبروت السلطة. إلخ.، إلخ. وفي مضمار الحب وأماني اللقاء ولوعة الفراق المحتوم، وهو مضمار للأفراد، أيّ نص يفوق الأغنية التي تعلـّق عليها فيروز، بلسان زياد، قائلة: "فعلا حلوي هالغنيي، بس جدّ انسميت"؟... أيّ نص يفوق هذه الأغنية في تسخير قوى الطبيعة وظواهرها لكبح الزمن الذي يذهب بالسعادة؟
ياريت!
إنت وأنا بالبيت،
ببيت أبعد بيت،
ممحي ورا حدود العتم والريح،
والتلج نازل بالدني تجريح،
يضيّع طريقك ما تعود تفلّ
وتضل حدّي تضلّ حدّي تضلّ
وما يضلّ بالقنديل نقطة زيت!
معنيان للهواء
يتحد سوء الحالة الجوية، إذن، وسوء المواصلات وغياب النور في نشر اللحظة – التي هي أمنية – إلى مدى الزمن كله. وأما لو كان زمام الأغنية في يد زياد لفقد الأمل في أن تقول الأغنية: "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم". لكانت الحبيبة لفتت نظر متيـّمها إلى أن الطريق مقطوعة والكهرباء مقطوعة وأنها طلبت إليه، من أول النهار، جالون كاز للمدفأة فقال إن النهار صاح ودافئ... وها هو الثلج يملأ الوديان وليس في قنديل الكاز نفسه نقطة كاز. وأما عن الموقد فـ "جب لنا موقدي من غناني أمك". ولكان اشتعل "النقار" بنقطة الكاز تلك واستذكر كل من الطرفين ما يذكره، حصرا، من القرارات السابقة ذات الصلة ثم ضاع الموضوع بين الصوتين المذعورين ومال طرف إلى جهة العولمة والآخر إلى جهة العولمة البديلة وتعصب طرف لأربعة أطراف إقليمية، سويـّة أو على التوالي، وتعصّب الآخر لطرف لبناني واحد وطرف دولي واحد أيضا، ولكانت الروايتان المحكمتان دارتا على محوريهما المتوازيين طيلة الليل:
بتقلـّلي بتضلـّي تعيدي وإنت العم تعيد.
سينسى الحبيبان خطر الموت، إذن، في هذا الليل الجليدي الطويل... وسينجوان من الموت فنبقى مدينين بهذه النهاية السعيدة لغليان الدم في العروق. هؤلاء هم البشر، عند زياد، وهذه هي الطبيعة أيضا. عند عاصي ومنصور، كانت شراسة الطبيعة نفسها ممكنة التسخير لأحلام البشر، واقفة على خدمة أمانيهم أو مظهرة لجلال سعيهم. عند زياد، يكفي أن يظهر شيئان خرجا من الأرض ليظهر معهما التنافر بين الناس:
واحد عم ياكل خس
وواحد عم ياكل تين!
وإذا كانت فيروز قد غنّت مع عاصي ومنصور:
نسّم علينا الهوا
من مفرق الوادي
يا هوا دخل الهوا
خذني على بلادي!
فهي ستغني بعد زياد:
الهوا، يا معلـّم!
رح يسفقنا الهوا، يامعلـّم!
الهوا، يا معلـّم!
لو بتسكّر هالشباك، يا معلـّم!
التمرين السابق (أي تخيـّلي ما قد يقوله زياد وصاحبته في بيت معزول تحت الثلج، ودعنا مما قد يفعلانه) هو، في كل حال، "شي فاشل" بما هو تمرين على الكتابة الزيادية. فإن رأس شروط الأخيرة، فضلا عن الموهبة، أن تكون عاميّة وأن يتخللها، بين الحين والحين، عزل لعبارة فصيحة يحوّل هذه العبارة، في السياق، إلى فضيحة كلامية. وهذا نفسه ما يفعله زياد بعبارات من أغان قديمة لفيروز. فإن شعر الرحبانيين فصيح التشكيل جدّا وإن يكن عاميّ اللهجة بمعظمه. وهو ابن نظرة صريحة هادفة في ما عليه العالم وفي ما يجب أن يكون عليه. قد لا توجد "لمبة" في شعر الرحبانيين كله ويصعب أن توجد فيه غسالة ما لم تكن من لحم ودم. وقد ينطفئ ألف قنديل أو سراج في ما تغنيه فيروز من شعرهما ولا تنقطع الكهرباء مرّة واحدة. وأما زياد فأحال "بريز أبو وئام" إلى شخص من شخوص مسرحه و"بطل" من "أبطال" الحرب اللبنانية. وهو قد عمد إلى الآليات السيارة من البوسطة (وهذه قد لا يمانع في تبنيها عاصي ومنصور) إلى "الكميون الموزون" وقبله "السيترن"، فأعادها إلى الغناء أو دفعها إلى المسرح... وكانت قد غابت، تقريبا، على ما أرجّح، بعد "يا وابور قلّـي" و "وقفّ خدني بأوتومبيلك"، أي بعد أن اكتمل دخولها في نسيج طرقاتنا ومسالك حياتنا اليومية.
"كان به"
هذا ولا توجد شهوة في شعر الأخوين رحباني لأن سموّ المعجم الشعري لا يترك منها شيئا ويردّها غير ما هي. وأما زياد فهو لا يتورع عن النزول إلى ما دون اللغة. وقد كنت تجاوزت عن سطرين من أغنية "لا والله" وجاءت مناسبتهما الآن:
ولك بس هوه هاي وين... بعلمي العقل كبير!
مش سمّ وهمّ وغمّ وذمّ وقدح وتشهير!
نزول إلى ما دون اللغة إذن... إلى مجرّد التنويع على الصياح وعلى حروف الزجر، وهذا في السطر الأول. يلي ذلك، في السطر الثاني، إفراط معجمي... وسأعود إلى كليهما. وفي ما خصّ الشهوة، لا نقع عند زياد أيضا على ما يوحي بالميل إلى اتخاذها موضوعا قائما بذاته. (أتخيل أنه لو قرأ هذا النص لقصّ عبارة "قائما بذاته" ووضعها في جيبه). يحلو لزياد – وهو على المزلق نفسه إلى ما دون اللغة – أن يتخذ من كلام الشهوة كنايات يعزّز بها بلاغة كلامه في السياسة:
يا زمان الطائفيي
طائفيي وطائفيك!
خلـّي إيدك عالهويـّي
شدّ عليها قد ما فيك!
ليس هذا كلام "أزعر" تلقاه في أي زقاق كان. هذا كلام أزعر ماكر. ماكر أي فنّان. ومن ذلك أن الإشارة الفاجرة في" طائفيك" سريعة العدوى، ينتقل مفعولها فورا إلى "الهوية".. فنعود غير مستيقنين من الموضع الذي يريدنا زياد أن نشدّ عليه.
ومن القبيل نفسه، أن زيادا علـّق، في أوائل الثمانينات، (إن لم أخطئ التقدير) إعلانات مربعة على أعمدة الكهرباء المزروعة في رصيفي نزلة البيكاديللي (وهو المسرح الذي قدّم فيه مسرحياته الحربية). كان الإعلان إعلانا عن مسرحية لم يشاهدها أحد بعد ذلك ولا قبله، وكان عنوانها "كان به". وأول ما تنبهت إليه، وأنا أنظر إلى هذا الإعلان، أنني لم أكن فكرت قط، طوال عشرات من السنين مضت، في كيفية تكوّن هذه العبارة وتلبـّسها المعنى الذي لها ولا في إعرابها. فأدركت أن مكر زياد وطرافته واقعان هنا بالضبط: في هذه القدرة على إقلاق الكلام المستقر فينا... على إزاحته شيئا ما عن مستقرّه... وعلى إلزامنا الكشف عن أحواله ومندرجاته وذيوله.
على أنني لما طال الأمر بهذا الإعلان، لعب الفأر في عبّي (أو دون ذلك بقليل). فغادرت همّ التمحيص اللغوي وأخذت أنظر في إخراج المشهد كله. قلت: إن تعليق هذا الإعلان على الأعمدة قد يكون صدفة محضة... ولكن... من يضمن هذا؟ من يضمن لي فعلا – ونحن معلـّقون من أعوام على خوازيق الحرب – ألا يكون العمود هو "اسم كان" المحذوف في العبارة؟ فيكون تمامها: "كان العمود به". ويكون العمود قد أكمل العبارة "بشخصه" عوض إكمالها باسمه. وكان عليّ أن أفكر، بعد ذلك، بالضمير المتصل في "به": إلى من يعود؟ واستبعدت أن يكون زياد قد خصّني شخصيا بواحد من تلك الأعمدة، إذ لم يكن بيني وبينه معرفة (ولا هي حصلت حتى اليوم). فلم يبق إلا أن أفترض للعبارة تتمة أخرى بحيث تقرأ: "من قرأ هذا الإعلان كان العمود به". بقيت، بعد هذه الدورة، معنيـّا بالهاء في "به". فقد كنت قرأت الإعلان مرارا وكان به! ولكن تعزيت – شأن أيّ لبناني لا يحترم نفسه – بأن العمود كان أيضا "بـ" أهل الحي جميعا وزواره أيضا، وهم قطعة كبيرة من شعبنا... "شعبنا العنيد" آنذاك إلى الحد الذي تعلمون.
أوديب ونقيضه
لم تغنّ فيروز "يا زمان الطائفيي" ولم تمثل في مسرحية ما لزياد. فما من أحد يكتب لأمـّه ما كان يكتبه زياد لنفسه أو لجوزف صقر من الأغاني. تلك أغاني ذكور أولا. وكانت فيروز قد جاءت إلى زياد وذيل ثوبها تراث باذخ تجرّه. ولعله ألزمها نصف التفاتة فألقت نظرة فاحصة على ذيل الثوب ذاك. ولكن لم يكن لزياد أن يلد أمه خلقا جديدا. وكان يكفيها تضحية أنها ربّته هذه التربية السيئة ليكون هذا من حسن فأله وفألنا. وتقول زوجتي، ثانيا، إن زيادا واحد من قلـّة بيننا اجتازوا "أوديبا" موفـّقا. فكان أنه أجهز على أبيه، فنيـّا، وأنشأ مع أمه شركة رمزية متغايرة الطرفين. وتزعم زوجتي أن السائد في مجتمعاتنا هو "الأنتي-أوديب"... أي أن الأهل يأكلون أولادهم، عادة، ليؤمـّنوا لأنفسهم الاستمرار بهؤلاء، على غرار القطط. لا أتقبل، من جهتي، المسؤولية عن هذا الرأي، وأعتقد أن صحته –إذا صحّ – لا تسهـّل طرق الحياة للقلـّة ولا للكثرة.
في كل حال، لا يوافق كلام زياد صوت فيروز، وهذا رأيي. فليس هذا اللون القارص المرّ لون الصباح الباكر ولا يسخر قمر هذا الصباح من أحد وإن تكن بالقمر خفّة لا تنكر... فيمكن أن يمازحنا باحتشام. غير أنني لا أرى في عدم التوافق هذا أدنى عيب. وإنما هو أقرب إلى مزج غير منتظر: إلى بعض أصناف الصلصة التي يبتكرها كبار الطهاة. أو إن امتزاج اللونين – إذا غادرنا الطعوم – يشبه أداء الرجل ذي الشاربين المفتولين دور الصبيـّة الصغيرة على المسرح. فهو قد يكون مقنعا جدا إذا كان... مقنعا. ههنا يحكي قمر الصباح الباكر بلايا آخر السهرة.
هوامش للجمهورية المتقطّعة
بقي عليّ أن أسأل: أين يقع عالم زياد إن صحّ أن عالم عاصي ومنصور يقع في ريف الجبل اللبناني وفي زمانه الذي لا يزال يبيد؟ هل يقع هذا العالم في المدينة؟ قد لا نجد له مدينة هنا. وكان عصام عبد الله، شريك زياد في أوائل عهده الإذاعي وأوائل الحرب، قد أعلن من تلك الأيام:
ما في مديني إسمها بيروت!
بيروت عنقود الضيع!
هذا كلام ينفذ إلى لبّ المشكل البيروتي (واللبناني) ولكن ليس شأنه أن يحيط بالمشكل المذكور. قد لا تكون بيروت مدينة وقد تكون تجسيما حرفيا لعنوان الديوان الأول الذي نشره أحمد عبد المعطي حجازي: "مدينة بلا قلب". وهي قد ظلت بلا قلب، حقيقة ومجازا، مدّة عشرين سنة هي، تقريبا، ثلثا العمر الفني الذي اجتازه زياد الرحباني إلى الآن. ولكن بيروت مدينة تتألف كلها – اليوم وقبل اليوم – من ضواح وهوامش. وهي، حين عاد إليها قلبها، عاد معدّا لغير أهلها، ولكن هؤلاء احتلّوه بقوة التنزّه والأكل والشرب فيه. وإن لم تكن بيروت مدينة البتة فهي ضواح وهوامش لمدينة غير موجودة وليست عنقود قرى لأن القرى عادت غير موجودة، هي نفسها، حيث كانت ومالت إلى التبدّل ضواحي وهوامش تبدّلا تتباين سرعته وتتنوع مجاليه. وما بدّله زياد الرحباني في تراث عائلته أنه أصبح لا يتخذ مرجعا لمخيلته ذاك الريف: الريف الذي كان عاصي ومنصور لا يزالان يقيمان فيه بالمخيلة حين كان قد زال من الوجود وبقي، مع ذلك، يطاول في الزوال. وقد كشف زياد بؤس الحياة في الضواحي والهوامش وكشف أن هذا البؤس لا يملك منفذا إلى عالم الخيال أي أملا حقـّا. فهذا البؤس إن حلم حلم بالمدينة، وهذه كان وجودها ناقصا، على الدوام، فاستقرت مساحة شبه عمياء للحلم ولم تتحصل له منها أشكال ولا ألوان ولا قواعد ولا أنماط سلوك ومعاشرة ومعاش. حتى الكورنيش والبحر ليسا أفقا. هل معنى هذا أن زياد الرحباني لا يحلم؟ بلى هو يحلم ولكنه فنان أحلام مكسورة. يقال إن زيادا شيوعي وإنه يحب ستالين. الثوريان الحقـّان هما عاصي ومنصور وإن تكن ثورتهما رجعية بمعنى أن مرجعها وراءها. وأما زياد فهو رجل وحيد ومرّ. وهو إن وحّدنا وحّدنا في الإقرار بما بيننا من تعازل ومرارات. هذا كثير طبعا ولكن هذا الكثير ليس مخرجا بحدّ ذاته ولا يدلّ شيء على أنه بدء لبحث، من جانبنا، عن طريق أو عن مخرج. وليس على زياد ملامة في افتقاد الطريق أو المخرج وليس شأنه أن يهدينا إليهما (فهذا يكون مملا جدا في العادة). وإنما يكفيه أن يثير فينا حاجة ما إلى البحث. في أغنية "صبحي الجيز"، وهي أغنية شيوعية، يشتكي زياد:
رفيقي صبحي الجيز تركني عالأرض وراح
رفيقي صبحي الجيز حطّ المكنسة وراح
وما قللي شو بقدر أعمل لملايين المساكين
رفيق، يا رفيق!
وينك، يا رفيق!
إلى أن يختم:
عم فتـّش عا واحد غيرك، عم فتـّش عا واحد متلك
يمشي يمشي، بمشي نمشي، نمشي ونكفّي الطريق!
فلا تغرّنا، بعد السماع، "ال" التعريف التي للـ"طريق". إذ لو كان صبحي الجيز ما يزال يعرفها، بعد كل ما جرى، لدلّ عليها الرفيق زيادا. على أن شيئا بقي برغم هذا الذي جرى. وهو أن الرفيق زيادا يريد رفيقا (واحدا، على الأقل) وأنه يريد أن يعمل شيئا لملايين المساكين. وقد يكفيه أن يمشي مع نفر منهم، على الأقل، نحو شيء ما وقد يخترعون طريقا إلى ذاك الشيء أو شطرا من طريق.
ولا يستغني أمر هذا الطريق أن يكون طريقا إلى المدينة وإلى الدولة معا. فهاتان متلازمتان، عندنا، في الحضور الذي يستوي غيابا، على الفور تقريبا، أو يستوي على شاكلة تفوق الغياب سوءا وهي شاكلة التنازع في جلد الدب المشهور والتناهش طلبا للصمود في انتظار صيده. وهذا مع العلم أنه لا يصاد بل يربّى وأنه، شأن الباندا، قد يعزف عن التوالد. أعود إلى "عدّية" فيروز في "لا والله":
مش سمّ وهمّ وغمّ وذمّ وقدح وتشهير!
فأما السمّ والهمّ فيوجد منهما كثير في القرى والمدن سواء بسواء. لذا لا يقودان خطانا إلى مكان بعينه. وأما الغمّ فاحترت في أمره قليلا ثم استقرّ ظني على أنه يجب أن يكون مولودا في بلدة جردية – بلدة إذن، لا قرية ولا مدينة – توجد فيها مدرسة ثانوية ليلعب معلموها الغرباء بالورق، بعد الدوام، مع التلاميذ الكبار. وأما الذمّ والقدح والتشهير فلها شأن آخر. هذا مصطلح شرائع وصحف. فلا بد إذن أن الدولة والمدينة موجودتان... أو لا بد أن الدولة-المدينة موجودة على نحو ما. على أي نحو؟ يفيد الحضور المحتمل للقرية في أول "العدّية" ومجاورتها البلدة قبل إفضائها إلى المدينة أن الحيرة قويّة. أو أن هذا ما أخمـّنه في أواخر هذا النص الذي لم أغادر فيه مناخ التخمين. فإذا صح تخميني، كنـّا حيال شيء لا يزال يراوح ما بين اتحاد الروابط العائلية (مع افتراض النزاع حاصلا بينها) ودولة القانون التامّة الأسنان. أو قل إن شئت إنها اتحاد لروابط الضواحي التي لم يصمد عندنا غيرها، بعد حروبنا. وذلك "رغم العيل والناس"، بمعنى من المعاني، وبالمواطأة في ما بينهم، بمعنى آخر... فماذا بعد؟
"إتسمّع عالموسيقى...موسيقى!"
كلمة أخيرة لغيري في موسيقى زياد. لغيري هي لأنني لست من أهل الكلام في الموسيقى، وإن يكن لي حظ (متواضع) من سماعها، وقد حصرتني صناعتي في الكلام على الكلام. مع ذلك أجازف بالقول إن موسيقى زياد تسهر وإنها، بخلاف كلامه، تنتشر على الجزء الأنيق الألـِق من السهرة. وهو الجزء الذي يلي الكأس الأولى حين يكون الساهرون جميعا ما زالوا أذكياء، ولمـّا تنطفئ الشموع في رأس أيـّهم. لا تجاري هذه الألحان كلام زياد، فهي تبقى حنونا وخفرة ولو ان الإيقاع يجهد، في بعض الحالات (من غير مبالغة في الجهد)، للموافقة على الكلام. ولا تجاري هذه الألحان صوت فيروز لأنها ألحان تسهر... تسهر بنوعها وتسهر بآلاتها أيضا. هذا فيما يبدو صوت فيروز وقد بكّر إلى اليقظة من راحة ليلية طويلة. على أنني لا أرى من عيب ههنا أيضا. فإن الصوت واللحن والكلام تتحاور ههنا من وديانها (أو من قممها) الثلاث. وهي تجيد الحوار فيأتي جميلا أيضا ويهزّنا ويقلقنا ويسلّينا.
فهل علينا أن نختار ما بين هذا الجمال وذاك الذي كان يتفتق عنه الانسجام ما بين الصوت القمري والشعر الألمعي والموسيقى المشرقة في عهد الشركة بين فيروز والرحبانيين الكبيرين أو أيضا بينها وبين زكي ناصيف أو، أخيرا لا آخرا، بينها وبين فيلمون وهبي؟ وما علينا إن أبينا الاختيار؟ من شاء فله أن يضيّق ملونة أذنه. وهو إذا اختار فيروز زياد، يكون قد غصب زيادا موقعه الفريد. فقد كان على الرجل أن يخرج على الرحبانية الأولى ليقول جديدا أو لينشئ بالكلام وبالموسيقى زمنا آخر. كان عليه أن يؤلف "شي فاشل" وسائر أعماله مما تلاها. وأما نحن فليس شأننا أن ننازعه ذلك. وهذا مع حفظ الحق لكل في ذوقه، طبعا، ومع استبعاد التعميم أيضا.
في ميدان آخر، ما يزال يسع كثيرين منتشرين عبر العالم أن يحبوا "ألف ليلة وليلة". وهذا مع أن عوالم للحكاية نشأت، من بعد تلك "الليالي"، فوق عوالم. وبقيت القاعدة أن من ابتغى مزاولة فن الحكاية مبدعا فلا بدّ له أن يمقت تلك "الليالي" من وجه ما. ولولا أن ذلك يحصل كل يوم لنضب الفن، والعياذ بالله.
بقيت إذن كلمة غيري في موسيقى زياد. وقد كنت بدأت كلامي على صوت فيروز بشيء من حديث الروح. وزوجتي تقول إن موسيقى زياد لفيروز "تأخذ الروح" معها. وأوافقها، من جهتي، على هذا من غير حاجة إلى التخصص. وأزيد أن الذي يكتب مثل هذه الموسيقى كان لزاما عليه أن يغادر في الكلام، بين وقت وآخر، لغة "ولك بس هو هاي وين" ليكتب كلاما تكون فيروز على سجية صوتها في أدائه ويكون (أي الكلام) منتميا أيضا إلى مناخ ألحانه. وقد فعل زياد هذا أحيانا، ولم يترك خاطر زوجتي مكسورا، فلحّن بالموسيقى التي "تأخذ الروح" معها كلاما يشير إلى ذلك:
بعتـّلك، يا حبيب الروح!
بعتـّلك روحي!
وقلتلك: ما دام حتروح
خذ معك روحي!
بيروت في 20-24 نيسان 2006